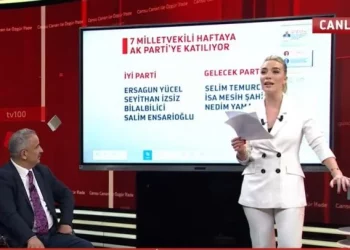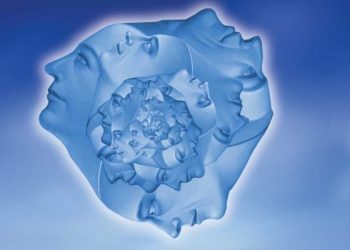بقلم/ مولاي المصطفى الهند
حقيقة العداء ووجوهه
حين أراد العلامة النورسي رحمه الله أن ينبه الأمة الإسلامية إلى بعض المظاهر الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تنشأ بين المسلمين، استعمل مصطلح “العداء”. فالعداء لا يعني فقط الظلم وتجاوز الحد، بل يعني كذلك الفساد والمنع والبعد. وبهذا يكاد يجمع النقائص كلها، فيحدث شرخا بين أفراد المجتمع. ومن هنا عبر الإمام النورسي عن مفهوم العداء فقال: “إن العداء ظلم شنيع يفسد حياة البشر الشخصية والاجتماعية والمعنوية، بل هو سمّ زعاف لحياة البشرية قاطبة”. فاعتَبر العداء مرفوضا بكل المقاييس؛ “ترفضه الحقيقة والحكمة، ويرفضه الإسلام الذي يمثل روح الإنسانية الكبرى”.
وقد ذكر لهذه الحقيقة ستة أوجه:
الأول: إن عداء الإنسان لأخيه الإنسان ظلم في نظر الحقيقة؛ فكما لا يجوز إغراق سفينة برمتها تضم مجرمِين طالما فيها بريء واحد، فإنه لا يجوز كذلك أن يحمل الإنسان لأخيه الإنسان في نفسه العداء والحقد لمجرد صفة إجرامية واحدة فيه. وموقفه هذا واضح لكونه يعتبر الإنسان بناء ربانيا وسفينة إلهية. وهذه لمحة فلسفية عميقة قلّما نجدها في الفكر الإسلامي.
الثاني: إن العداء ظلم في نظر الحكمة، إذ العداء والمحبة نقيضان، فهما كالنور والظلام لا يجتمعان معا بمعناهما الحقيقي أبدا. فإذا ما اجتمعت دواعي المحبة وترجحت أسبابها فأرست أسسها في القلب، استحالت العداوة إلى عداء صوري، بل انقلبت إلى صورة العطف والإشفاق، إذ المؤمن يحب أخاه، وعليه أن يوده، فأيما تصّرف مشين يصدر من أخيه يحمله على الإشفاق عليه، وعلى الجد في محاولة إصلاحه باللين والرفق دون اللجوء إلى القوة والتحكم. أما إذا تغلبت أسباب العداوة والبغضاء وتمكنت في القلب، فإن المحبة تنقلب عندئذ إلى محبة شكلية تلبس لبوس التصنع والتملق.
ونبه الأستاذ إلى ما يرتكبه الإنسان من ظلم في حق أخيه الإنسان حين يستعظم زلات صدرت منه في حقه، ويستهول هفوات وسلوكات مشينة ارتكبها. فمهما ارتكب الإنسان المؤمن في حق أخيه المؤمن من أخطاء وزلات فإنها جد بسيطة إذا ما قورنت بعظمة إيمانه وسمو إسلامه.
ومن هنا جاءت دعوته إلى وحدة المجتمع الذي هو من مقتضيات وحدة العقيدة التي ترتبط بوحدة قلوب المؤمنين، فقال رحمه الله: “إن خالقكما واحد، مالككما واحد، معبودكما واحد، رازقكما واحد… وهكذا واحد، واحد… إلى أن تبلغ الألف. ثم إن نبيكما واحد، دينكما واحد، قبلتكما واحدة… وهكذا واحد، واحد… إلى أن تبلغ المائة. ثم إنكما تعيشان معا في قرية واحدة، تحت ظل دولة واحدة، في بلاد واحدة… وهكذا واحد، واحد إلى أن تبلغ العشرة”.
الثالث: العدالة المحضة الواردة في الآية الكريمة: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾(الأنعام:164)؛ حيث لا يجوز أن يعاقَب إنسان بجريرة غيره. ويوضح كيف أن العداء الذي يحمله الإنسان المؤمن بين جنبيه تجاه أخيه المؤمن هو ظلم عظيم، لأنه إدانة لجميع الصفات البريئة الطاهرة التي يتصف بها. وبما أن الظلم لا يجر وراءه إلا المفاسد والمهالك، فإن هذه المفاسد هي سبب العداء والبغضاء، وهي كثيفة في نظر الحقيقة، “وشأن الكثيف أنه لا يسري ولا ينعكس إلى الغير -إلا ما يتعلمه الإنسان من شر من الآخرين- بينما البر والإحسان وغيرهما من أسباب المحبة، فهي لطيفة كالنور وكالمحبة نفسها، ومن شأن النور الانعكاس والسريان إلى الغير”.
الرابع: إن العداء للمؤمن ظلم مبين من حيث الحياة الشخصية، ووضّح هذه الفكرة من خلال جملة من الدساتير:
• إن الإنسان له أن يدّعي أن مسلكه حق أو هو أفضل، لكن لا يجوز أن يدعي أن الحق مسلكه هو فحسب، لأن نظره الناقص لا يخول له ذلك، وهذا تنبيه له حتى لا يقع في خطأ تجاه أخيه الإنسان.
• عليك أن تقول الحقَّ في كل ما تقول، ولكن ليس لك أن تذيع كل الحقائق. وعليك أن تصدُق في كل ما تتكلمه، ولكن ليس صوابا أن تقول كل صدق.
• كل من يريد العداء، عليه أن يبدأ بعداوة ما في قلبه وما تحمله نفسه، فبهذا فليبدأ، وبعد ذلك يمكنه أن يعادي خصمه، وإن أردت أن تغلب خصمك فادفع سيئته بالحسنة، فبه تخمد نار الخصومة. أما إذا قابلت إساءته بمثلها فالخصومة تزداد، حتى لو أصبح مغلوبا -ظاهرا- فقلبه يمتلئ غيظا عليك، فالعداء يدوم، والشحناء تستمر.
• مرض الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويأتي على الأخضر واليابس في حقل العلاقات الاجتماعية. فالحاسد يعذب نفسه عذابا أليما، ولا يلحق المحسود شيء منه؛ فإذا كان ناشئا عن أمور دنيوية فالأحرى للحاسد أن لا يهتم به لأنها أمور زائلة وفانية، وإذا كان منشؤه عن دوافع أخروية فليس فيها حسد أصلا.
وفي حالِ إذا مست الإنسانَ المسلم إساءة من أخيه المسلم، فلا يجب عليه أن يدينه وحده، لأن عوامل أخرى تتدخل في الموضوع، منها:
أ-القدر الإلهي له حظه في الأمر، فعليك أن تستقبل حظ القدَر هذا بالرضى والتسليم.
بـ-إن للشيطان والنفس الأمارة بالسوء حظهما كذلك. فإذا ما أخرجتَ هاتين الحصتين لا يبقى أمامك إلا الإشفاق على أخيك بدلا من عدائه. لأنك تراه مغلوبا على أمره أمام نفسه وشيطانه. فتنتظرُ منه بعد ذلك الندمَ على فعلته، وتأملُ عودته إلى صوابه.
جـ-عليك أن تلاحظ في هذا الأمر تقصيرات نفسك، تلك التي لا تراها أو لا ترغب أن تراها، فاعزل هذه الحصة أيضا مع الحصتين السابقتين، تر الباقي حصة ضئيلة جزئية، فإذا استقبلتها بهمة عالية وشهامة رفيعة أي بالعفو والصفح، تنجو من ارتكاب ظلم وتتخلص من إيذاء الآخرين.
الخامس: مدى الضرر البالغ الذي يصيب الحياة الاجتماعية جراء العناد والتنافر والتفرقة؛ وردّ على أولئك الذين يستشهدون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “اختلاف أمتي رحمة”، ويتخذونه مطية لتبرير النـزاع والشقاق والاختلاف، ففسر الحديث تفسيرا ينمّ عن حظه الوافر في فقه الحديث فقال: “إن الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف الإيجابي البنّاء المثبت. ومعناه أن يسعى كل واحد لترويج مسلكه وإظهار صحة وجهته وصواب نظرته، لإكمال النقص ورأب الصدع والإصلاح ما استطاع إليه سبيلا. أما الاختلاف السلبي فهو محاولة كل واحد تخريب مسلك الآخرين وهدمه، ومبعثه الحقد والضغينة والعداوة، وهذا مردود أصلا في نظر الحديث، حيث المتنازعون والمختلفون يعجزون عن القيام بأي عمل إيجابي بناء”.
وختم النورسي هذا الوجه الخامس بتوجيه نداء إيماني حار إلى أهل الإيمان والإسلام ينبههم فيه إلى مكامن القوة والضعف عندهم، ويجلّي لهم الفوارق بين العزة والذل، وكيف أن تضخيم صوت “أنا” في النفس قد يكون سببا مباشرا في هلاك الأمة، وهكذا قال: “أيها المؤمنون! إن كنتم تريدون حقا الحياةَ العزيزة، وترفضون الرضوخ لأغلال الذل والهوان، فأفيقوا من رقدتكم، وعودوا إلى رشدكم، وادخلوا القلعة الحصينة المقدسة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾(الحجرات:10)، وحصنوا أنفسكم بها من أيدي أولئك الظلمة الذين يستغلون خلافاتكم الداخلية. وإلا فستعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل حتى عن الحفاظ على حياتكم، إذ لا يخفى أن طفلا صغيرا يستطيع أن يضرب بطلين يتصارعان، وأن حصاة صغيرة تلعب دورا في رفع كفة ميزان وخفض الأخرى، ولو كان فيهما جبلان متوازنان”.
السادس: كان مقتضبا ومختصرا، تناول فيه الإخلاصَ باعتباره وسيلة ناجعة لما يمكن أن يصدر من الإنسان المسلم من عداء وظلم تجاه العباد. وأشار إلى أمر خفي مهم لا يكاد ينتبه إليه الكثير من الناس، وهو أن المعاند الذي ينحاز إلى رأيه وجماعته يروم التفوق على خصمه حتى في أعمال البر التي يزاولها. فلا يوفَّق توفيقا كاملا إلى عمل خالص لوجه الله. ثم إنه لا يوفق أيضا إلى العدالة، إذ يرجح الموالين لرأيه الموافقين له في أحكامه ومعاملاته على غيرهم. وهكذا يَضيع أساسان مهمان لبناء البر: “الإخلاص والعدالة” بالخصام والعداء.
وبهذه المقارنة الشمولية استطاع أن يؤسس لنا تصورا رفيعا لبناء علاقة اجتماعية تسودها المحبة والسلام والألفة والأخوة، تكون هي السقف التربوي التي تعول عليها البشرية -بما فيها الأمة الإسلامية- لتحيا في أمن وطمأنينة وسلام.
حقيقة التعارف بين الشعوب
أورد النورسي الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾(الحجرات:13)، واتخذها سقفا معرفيا لتصوره لحقيقة التعارف بين الشعوب كما هو وارد في الشريعة الإسلامية السمحة، وشبه المجتمع الإسلامي بقبائله وطوائفه بجيش مقسم إلى فيالق وفرق وألوية وأفواج وسرايا وفصائل وحظائر، وما هذا التقسيم إلا ليَعرف كل جندي واجباته حسب تلك العلاقة المختلفة المتعددة من جهة، ولتصان حياتهم من هجوم الأعداء من جهة ثانية.
الإجراءات التربوية والإيمانية للتعايش السلمي
حدد الأستاذ لتطبيق التعايش السلمي بين الناس في مجموعة من الضوابط والمعالم التربوية والإيمانية ذات النفع الكبير على الفرد والمجتمع، نجمل بعضها فيما يلي:
أ-الإيمان: اعتبر الأستاذ الإيمان أسمى غاية للخلق وأعظم نتيجة للفطرة، وأفضل مقام للبشرية. ومن هنا دعا رحمه الله الناس إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، لأن هذا من شأنه أن يريحهم من العنت والضنك الذي يعيشونه في حياتهم الخاصة والعامة، ويجعل المجتمعات البشرية تعرف أنواع السعادة الحقة والسرور الخالص، فتعيش في أمن وأمان واستقرار تحت رحمة الخالق سبحانه.
وأكد على أن كل من عرف الله تعالى حق المعرفة، وملأ قلبه من نور محبته، سيكون أهلا لسعادة لا تنتهي ولنعمة لا تنضُب ولأنوار وأسرار لا تنفد، وسينالها إما فعلا وواقعا أو استعدادا وقابلية.
بـ-الإخلاص: اعتنى الأستاذ في رسائله بالإخلاص أيما عناية، اعتقادا منه أن فيه أنوارا مشعة وقوى رصينة كثيرة من شأنها أن توثق عرى المحبة والأخوة بين الناس.
ونظرا لأهمية الإخلاص في حياة الإنسان، جعل له الأستاذ أربعة دساتير اتخذت صفة توجيهات تربوية لعموم المسلمين، نجملها كالآتي:
• ابتغاء مرضاة الله في العمل، فإذا رضي هو سبحانه فلا قيمة لإعراض العالم أجمع ولا أهمية له.
• عدم انتقاد من يعمل في هذه الخدمة القرآنية، وعدم إثارة نوازع الغبطة بالتفاخر والاستعلاء.
• القوة في الحق والإخلاص، حتى إن أهل الباطل يحرزون القوة لِما يبدون من ثبات وإخلاص في باطلهم.
• الافتخار -مع الشكر- بمزايا الإخوان، وتصورها في الأنفس.
جـ-الأخوّة: تحدث الأستاذ عن الأخوّة واعتبرها دستورا جميلا يجب الاعتماد عليه لتجاوز الكثير من المشاكل والعراقيل بين الناس، وهو ينبثق من الدستور الإلهي: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾(الحجرات:10).
والذي يميز مفهومه للأخوّة عن غيره من العلماء هو استخدامه لتعبير دال عن المعنى العميق للأخوة، وذلكم هو اصطلاحه “الفناء في الإخوان” أي أن يفنى كل في الآخر، “بأن ينسى كل أخ حسياته النفسانية ويعيش -فكرا- مع مزايا إخوانه وفضائلهم. حيث إن أساس مسلكنا ومنهجنا هو “الأخوّة في الله”، وإن العلاقات التي تربطنا هي الأخوة الحقيقية، وليست علاقة الأب مع الابن ولا علاقة الشيخ مع المريد. وإن كان لابد فمجرد العلاقة بالأستاذ. وما دام مسلكنا هو “الخليلية” فمشربنا إذن “الخلة”. والخلة تقتضي صديقا صدوقا ورفيقا مضحيا وأخا شهما غيورا. وأسُّ الأساس لهذه الخلة هو “الإخلاص التام”. فمن يقصّر منكم فيه فقد هوى من على برج الخلة العالي، ولربما يتردى في واد سحيق، إذ لا موضع في المنتصف”.
د-المحبة: وهي ركن أساس في العلاقة الاجتماعية بين الناس، ولا يمكن تصور مجتمع يعيش في أمن واطمئنان دون الحديث عن المحبة التي تعمر قلوب أصحابه ونفوسهم. ولهذا أَولاها أهمية خاصة في رسائله النورانية، واتخذ منها نبراسا يَهتدي بنوره طلابُه والإنسانية جمعاء. ولا غرابة أن نجده يعتبر المحبة سر الوجود والكائنات، وأضفى عليها مسحة تربوية رفيعة، حيث ربط بينها وبين القصد منها، فإن كانت محبةً لله دامت واتصلت وآتت أكلها في الدنيا والآخرة، وإن كانت لغير ذلك فهي غير نافعة ولا أثر لها.
ومن هنا فإنه تحدث عن المحبة في جميع علاقات الإنسان الاجتماعية، ووثقها بخيط نوراني رفيع يتصل بالخالق سبحانه وتعالى، فأكد على أن محبة هذا الإنسان للوالدين واحترامهما، إنما يعودان إلى محبته لله سبحانه؛ إذ هو الذي غرس فيهما الرحمة والشفقة حتى قاما برعايته وتربيته بكل رحمة وحكمة. وعلامة كونها محبة لوجه الله تعالى هي المبالغة في محبتهما واحترامهما عندما يبلغان الكبر ولا يبقى له فيهما من مطمع.
أما محبة الأولاد فهي كذلك محبة لله تعالى وتعود إليه، وذلك بالقيام برعايتهم بكمال الشفقة والرحمة بكونهم هبة من الرحيم الكريم. ثم إن محبة الزوجة وهي رفيقة الحياة، فعلى الإنسان أن يحبها على أنها هدية أنيسة لطيفة من هدايا الرحمة الإلهية. وعليه أن لا يربط محبته لها برباط الجمال الظاهري السريع الزوال، بل يوثقها بالجمال الذي لا يزول، بل يزدادُ تألقا يوما بعد يوم، وهو جمال الأخلاق والسيرة الطيبة المنغرزة في أنوثتها ورقّتها. والحياة أيضا التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي رأس مال عظيم يستطيع أن يكسب به الحياة الأخروية الباقية. من هنا فالمحافظة عليها ومحبتها من هذه الزاوية، وتسخيرها في سبيل المولى عز وجل تعود إلى الله سبحانه أيضا. وهكذا فإن جميع ما ذكرناه من أنواع المحبة، إن وُجهت الوجهةَ الصائبة، أي عندما تكون لله وفي سبيله، فإنها تورث لذة حقيقية بلا ألم، وتكون وصالا حقا بلا زوال، بل تزيد محبة الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أنها محبة مشروعة وشكر لله في اللذة نفسها، وفكر في آلائه في المحبة عينها.
هـ-الصدق: اعتبره الأستاذ حجر الزاوية في الحياة الاجتماعية للإنسان، وبه يداوي أمراضه المعنوية. وأكد على أن الكذب من قبيل المداهنة والتصنع دنيء ومرفوض، فاختلط الحق بالباطل، وتاه الناس عن سبيل الله المستقيم، فاختلطت كمالات البشرية بسفاسفها ونقائصها، وعمت المجتمعات البشرية فوضى واضطرابات عذبت الإنسانية عذابا شديدا في روحها ونفسها وقلبها.
و-الأمل واستشراف المستقبل: نظر الأستاذ إلى الإنسان نظرة جامعة تخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتها وسعة الآخرة، وأكد على أن مقام الإنسان الراقي بسجاياه السامية لا يتحقق إلا إذا تجاوز حاضره الضيق الذي يجعله في علاقة اجتماعية محدودة الأثر والنتائج، فلا يرقى أبدا إلى مرتبة الصدق في الوفاء، ولا إلى مكانة الإخلاص في الصداقة، ولا إلى درجة الود في المحبة، ولا إلى الاحترام المبرأ من الغرض في الخدمة.
ومن هنا تأتي دعوة الأستاذ الإنسانَ إلى تغيير منطق تعامله مع محيطه الاجتماعي بأمل كبير واستشراف مستقبليّ من نوع فريد وخاص، أجمَله -رحمه الله- في كلمتين اثنتين: “الإيمان بالآخرة”. هذا الإيمان الذي يعتبر إكسيرَ حياةِ البشر، وما إن يأتي “الإيمان بالآخرة” إلى هذا الإنسان لينقذه ويمده ويغيثه، حتى يحوّل ذلك الزمن الضيق -الشبيه بالقبر- إلى زمان فسيح واسع جدا بحيث يستوعب الماضي والمستقبل معا، ولا يجعل هذه الدائرة الحياتية الواسعة الفسيحة -وما فيها من علاقات وخدمات مهمة- وسيلة لأمور تافهة دنيوية ولا لأغراضها الجزئية ومنافعها الزهيدة.