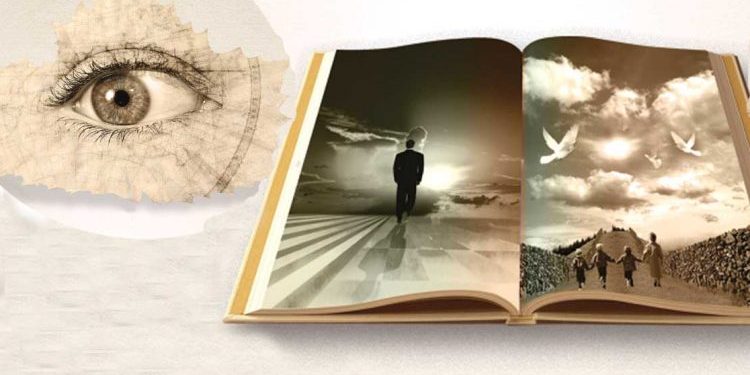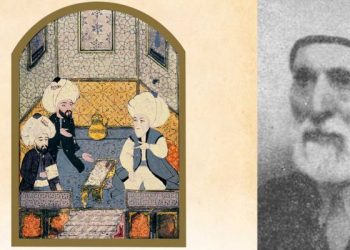بقلم/ خالد الصمدي
والأقوال والأفعال. قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾(الملك:2) وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾(الذاريات:56). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”.(رواه الإمام أحمد)
مقاصد التربية والتكوين في التصور الإسلامي
إن هذا الأسلوب في بناء الفكر المنهجي والمقاصدي لدى الإنسان يلغي من ذهنه العبثية والصدفة، ويربيه على رسم الأغراض الذاتية الواضحة في سياق الغايات المتوافق عليها في المجتمع المسلم، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْـتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ﴾(المؤمنون:115).
وفي هذا السياق العام نقرأ دعاء إبراهيم * لأمّته حين قال: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾(البقرة:129). فكانت المقاصد الكبرى لإخراج الأمة للناس ملخصة في ثلاث:
المعرفة: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾، والأولى أعم من الثانية، لأن الآيات تشمل كتاب الله المنظور والمسطور بما يضمان من سائر العلوم.
الحكمة: وهي كل مهارات التواصل والخطاب والتصرف التي تمكن الفرد والجماعة من إقناع الناس بالحق وللحق، وإذا كان الله تعالى يعطي المعرفة لمن يحب نعمة ولمن لا يحب امتحانا ونقمة، فإن الحكمة لا يؤتيها إلا لصفوة ممن يشاء من خلقه ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ﴾(البقرة:269).
التزكية: وهي تَمازُج الإيمان بالوجدان، يدلّ على ذلك تمسك الفرد بمنظومة القيَم الأخلاقية الفردية والجماعية في أرقى مستوياتها، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾(الشمس:9-10).
ونجد الربط بين طلب المعرفة، ومهارة القراءة والكتابة، والتربية الإيمانية، في أوّل آية نزلت من القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾(العلق:1-5). فالقراءة والربّ والقلم الواردة في الآية واضحة في الدلالة على المراد.
ومن منهج القرآن والسنة المزج بين هذه المقاصد الثلاثة في كل الأحوال التي يتحدث فيها عن الإنسان فصلا ووصلا؛ فالفاصل بينها شقي والواصل سعيد، وهما صورتان بارزتان في القرآن الكريم، أُولاهما صورة قارون الذي اغترّ بعلمه حين انفصل عن القيم فقال مزهوا بعد التمكّن المعرفي الذي أكسبه أموالا ما إن مفاتحها لتنوء بالعصبة أولي القوة ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾(القصص:78)، قال تعالى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾(القصص:81). وقال الذين اغترّوا بمظهره ومكانته قبل قليل ﴿يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾(القصص:79). ولكنهم قالوا بعد الخسف: ﴿لَوْلاَ أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾(القصص:82). لأن العلم في هذه الحال ما زاد قارونَ إلا علوا واستكبارا، إذ هو في هذه الحال علم مدمِّر، ألا ترى أتباع قارون في عصرنا وقد صنعوا أسلحة الدمار الشامل ومحَوا بها أقواما من البسيطة، ولعبوا بالجينات في غياب الأخلاق؛ فخلطوا الأنساب واستغلوا الصناعات الفضائية للجاسوسية وقهر الشعوب، فكشفوا بذلك عن الوجه البشع للعلم حين ينفصل عن القيم.
وصورة ذي القرنين الذي نجح في بناء سد من زُبَر الحديد وقِطر النحاس، وجعله حائلا بين إفساد يأجوج ومأجوج والقوم الصالحين من الموحّدين ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾(الكهف:97)، وحين عجب الناس من صنيعه وعلمه قال: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾(الكهف:98). فربط المعرفة بقيم التوحيد وإجلال العالم الجليل، فكان صنيعه حائلا بين الحق والباطل إلى أن يشاء الله.
وفي ضوء هذين النموذجين المذكورين في القرآن الكريم، على واضعي المناهج التعليمية في البلدان الإسلامية أن يحدّدوا غاياتهم من أنظمة التعليم، فإن اختاروا النموذج الأول، فإن المآل لن يكون إلا الخسف بمفهومه الحضاري الواسع، وإن اختاروا النموذج الثاني كان علمهم رحمة بالبشرية وإنقاذا لها.
مقاصد التربية في الفكر الإسلامي
نكاد نجزم أن علماء التربية المسلمين استوعبوا المقاصد التربوية النظرية النابعة من أصول التربية الإسلامية كما حددناها في الفقرات السابقة، وصاغوا غاياتهم التربوية في ضوئها، إلا أن البارز من تحليل كتاباتهم التربوية هو قدرتهم على تكييف غايات التربية مع متطلبات الزمان والمكان؛ فابن سحنون في القيروان، هو غير ابن عبد البر وابن حزم والقاضي عياض في الأندلس والمغرب، وهؤلاء غير الإمام الغزالي في المشرق، وإن كان الجميع ينهل من حوض واحد. والمستفاد من هذا المنهاج هو إقرار الجميع بضرورة تكييف المناهج التعليمية مع متطلبات العصر ومتغيراته وحاجاته.
وتعكس النماذج التالية هذا التنوع المحكوم بالخلفية الفكرية لكل عالم ومتغيرات عصره السياسية والاجتماعية. فالعلم عند أبي عمر يوسف بن عبد البرّ (الفقيه المحدّث المالكي القرطبي المولود سنة 368 هـ والذي عاصر زمن الطوائف الأول بعد سقوط الخلافة وقبل عصر المرابطين) يهدف إلى إرضاء الله وخشيته وحسن العلاقة به في العبادة وتكوين علاقة طيبة بعباده، كما يهدف إلى نفع المسلمين في دنياهم عقليا ووجدانيا وماديا. فالرجل ركز على الإخلاص ونبذ حظوظ النفس لما عايشه من خلافات ذاتية عصفت بمصير الخلافة الإسلامية بالأندلس، ولا سبيل لإعادة العزة للمسلمين إلا بهذا المسلك الذي ينبغي أن تربّى عليه الأجيال.
وحدد بدر الدين بن جماعة (ت: 733هـ) الفقيه الشافعي الشامي الذي عاصر فترة أهوال سقوط بغداد في يد المغول والصراع مع الصليبيّين، المقاصد العامة لطلب العلم في: 1-فهم الدين ومعرفة أصوله وأحكامه وقواعده. 2-حمل العلم عن السلف. 3-الدفاع عن الدين وعلومه الصحيحة ضد التحريف والانتحال والتأويل.
ولا شك أن حملات التشكيك التي بثّها الصليبيون والفرق المنحرفة عن الإسلام وتاريخه وحضارته وثقافته اقتضت أن يركز الرجل في المقاصد الكبرى للتعليم على تجديد فهم الدين وفق رؤية سلفية متأصلة والدفاع عن الدين الذي هُددَت حياضه وتداعت عليه الأمم.
وقد جعل ابن سينا (ت: 427هـ) مقصد التربية والتعليم تنمية القوة المدركة، ولَفَت النظر إلى أهمية الحكمة فقسمها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يرتبط بأخلاق المرء وأعماله حتى تكون حياته الأولى والأخرى سعيدة.
القسم الثاني: يرتبط بتدبير المرء لمنـزله المشترك بينه وبين زوجه وولده ومملوكه حتى تكون حاله مؤدّية إلى كسب السعادة.
والقسم الثالث: أصناف السياسات والرئاسات والاجتماعات المدنية الفاضلة والرديئة، فيعرف وجه استيفاء كل واحد منها وعلة زواله.
قال الدكتور هشام نشابة، محقق كتاب السياسة لابن سينا “وهذه التوجيهات تصلح أن تكون أساسا لوضع منهاج دراسي لمختلف مراحل التعليم”.
والأثر الفلسفي في رؤية الرجل لمقاصد التربية والتعليم نابعة من اطلاعه على مقومات تكوين الإنسان في الفلسفة اليونانية بوجه خاص، والسعي إلى تكييف هذه الرؤية مع التصور الإسلامي، مما يجعل الإنسان قادرًا على تدبير شؤون الحياة الفردية والجماعية مع الحرص على كسب السعادة في الدارَين.
ومن قراءته المعمقة في الفكر التربوي عند ابن خلدون (عالم الاجتماع والعمران المولود سنة 732 هـ بـ”تونس”، والذي جاب أقطار المغرب والأندلس زمن بني الأحمر، واحتكّ بنصارى قشتالة، وعاصر ضعف المسلمين وصراعاتهم بالأندلس) يستنتج الدكتور عبد الأمير شمس الدين أن المقاصد التربوية عند الرجل تتمثل في: 1-تربية الملكات، 2-اكتساب الصناعة، 3-البناء الفكري السليم.
وهي المقومات الكبرى للعمران، وهي نظرة بعيدة تلخّص علاج مشكلات الانحطاط في العالم الإسلامي في العصور الوسطى، والتي تحتاج إلى فهم السنن الكونية في قيام الحضارات وسقوطها، وهي رؤية يقصد ابن خلدون إلى ترسيخها لدى الأجيال الصاعدة، لأن تغيير مصير ومسار الأمم يبدأ بتغيير التصورات وتنمية المهارات والقدرات.
وبذلك يظهر جليًّا أن هذه الآراء التربوية التي أنتجها الفقيه والمحدث والفيلسوف وعالم الاجتماع في ظروف مختلفة لم تخرج عن المقاصد الكبرى للتربية في الإسلام، لكنها أصبحت أكثر إجرائية حينما حكمتها الخلفية الفكرية لكل عالم، والبيئة المعرفية والسياسية التي حكمت عصره، ورؤيته لسبل التصحيح والتغيير التي ستقوم بها الأجيال بعده، وهي الفكرة المركزية التي يمكن استنتاجها والاستفادة منها لتكييف مقاصدنا التربوية المعاصرة مع متطلبات واقعنا ومتغيراته وحاجاته.
إننا نعتقد أن بناء مناهج التعليم وكذلك العمليات الفرعية المرتبطة بها في أي بلد حَسَم خياراته الدينية والمذهبية باعتماد المرجعية الإسلامية النصية، والاجتهاد المقاصدي، واستلهام التجارب الإنسانية التي لا تتعارض مع ذلك، ينبغي أن تبنى مناهجه التعليمية وفق أسس أربعة:
1- الأساس الفلسفي: وينبني على الخصوصيات العقائدية للأمة ونظرتها إلى الكون والحياة والمصير باعتبارها محدِّدات رئيسة لتكوين رؤية الإنسان لمبررات وجوده وحياته ومصيره.
2- الأساس الاجتماعي: ويرتكز من جهة على الإمكانات المتاحة في كل مجتمع لتنفيذ نظام متجدد للتربية والتكوين، ومن جهة ثانية حاجاته التنموية على المدى القصير والمتوسط.
3- الأساس النفسي: ويرتكز على ضرورة مراعاة النموّ النفسي والإدراكي للمتعلمين في مختلف الأعمار، ومسايرة تطوره لتوسيع دائرة التفاعل مع برامج ومناهج التعليم في انسجام وتناغم، مما يُنتج دافعية أكبر نحو التعلم.
4- الأساس المعرفي: فيراعي طبيعة المفاهيم التي تقدَّم للتلاميذ، وكيفية إسهامهم في بنائها في شكل خرائط معرفية متسلسلة بأسلوب منهجي لا يقتصر فيه دور المتعلم على التلقّي، بقدر ما يشارك في بناء المعرفة وفق نسق يمكنه من الأدوات المعرفية الضرورية للتنمية، ويؤهّله لإدراك المقاصد الكبرى للعلم الموصلة إلى معرفة الخالق وتقديره حق قدره.
وحين نتحدث عن النظام التربوي والتعليمي بهذه الصيغة المركبة فإننا نرسخ بذلك مبدأين أساسيين:
1- أنه لا فصل بين التربية والتعليم، وإن كان هذا الفصل موجودًا في الواقع اليومي المدرسي الذي أصبح الشأن التعليمي يهيمن فيه على الشأن التربوي والأخلاقي.
2- أن النظام التربوي التعليمي شبكة من العلاقات والخطابات والوسائل يتداخل فيها سلوك المعلم، وفضاء القسم، والمحتوى التعليمي، والأنشطة التعليمية، وجماعة المتعلمين، والإدارة المدرسية وغيرها.. فلكل طرف سلطته التي يمارسها، والمستهدف واحد طبعًا هو المتعلم الذي نعتقد أنه ينبغي أن يتوفر على مواصفات وكفاءات ثلاث تجعل منه عنصرًا نافعًا لنفسه ومجتمعه:
أ- القدرة على الإسهام في عملية بناء المعارف بمختلف أنواعها، وعدم اقتصاره على تلقيها واستيعابها، وامتلاك آليات تجديد التكوين الذاتي المستمر مدى الحياة.
بـ- امتلاك المهارات العقلية (التحليل – النقد – التعليل – التصنيف – الاستدلال – التمييز – الاستشراف – الحوار) والتقنية (امتلاك القدرة على الإنتاج العلمي والتقني المهني واستثمار تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التكوين والبحث والتواصل).
جـ- ترسيخ القيم التي تحكم علاقاته مع خالقه ومجتمعه ونفسه؛ وهي قيم مثلى تؤهله للقيام بمهمة الاستخلاف.
فإلى أي حد استجابت مقاصد أنظمتنا التربوية الإسلامية المعاصرة لهذه القواعد والمبادئ ولحاجات واقعنا المعاصر يا تُرى؟!