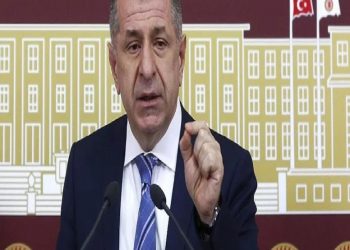بقلم: محمد إيفه تشامان
بروكسل (زمان التركية) – أحيت الإدارة الإسلامية الفاشية في تركيا من جديد مصطلح “الكيان الموازي” أو “الدولة الموازية”، وذلك عندما بدأت البلديات في عدد من المدن الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة، تقديم المزيد من الخدمات الصحية والدعم الاجتماعي للمواطنين -في ظل تفشي كورونا- بعدما عجزت الحكومة المركزية عن تقديمها لهم.
وكما تعلمون، فإن هذا المصطلح كان يستخدم في البداية للإشارة إلى حركة الخدمة -جماعة فتح الله كولن-؛ فعقب فضائح الفساد التي شهدتها البلاد في 17 ديسمبر 2013، تواطأت هذه الفاشية الإسلامية مع الدولة العميقة، وابتكرت مصطلح “الكيان الموازي” الذي يسعى لاختراق الدولة وزلزلتها، وذلك من أجل إنقاذ الفاسدين والمجرمين من الطرفين.
هذا المفهوم، الذي تولد من رحم هؤلاء الإسلاميين الفاشيين، ودخل لأدبنا السياسي، حقق أهدافه وترسخ في عقول الشعب التركي، ومن ثم بدأ يطلق اليوم على الإدارات المحلية التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، الأمر الذي يفرض علينا الوقوف عنده للكشف عن أبعاده وخلفياتها التاريخية وجذوره الفلسفية.
في الواقع يمكن إرجاع مقاربة الدولة الموازية أو الكيان الموازي إلى تقليد الدولة المركزية الموجودة في ثقافتنا السياسية، فتقاليد الدولة التركية تقوم على الدولة المركزية وسلطة الدولة المطلقة، والمفهوم المقابل لها هو الدولة اللامركزية. في الدول اللامركزية يتم تقاسم السلطات بين المركزية والمحلية، ومهما حدد المركز توجها سياسيا رئيسيا، إلا أن الوحدات المحلية تتخذ قرارات أيضا في المناطق التابعة لها. وهذا يخلق نوعا من توازن القوى بين الوحدات المركزية والمحلية. بينما في نموذج الدولة المركزية فإن المركز يمسك بزمام الأمور في يديه، بما في ذلك أصغر الأمور، ولا يمنح الإدارات المحلية أي حق في المشاركة في أي من مراحل اتخاذ القرارات.
رغم منح حرية معينة للعناصر المحلية في بداية الإمبراطورية العثمانية، فقد انخفض هذا بمرور الوقت. فمنذ القرن الثامن عشر، وحتى انهيار الإمبراطورية، تراجعت سلطات العناصر المحلية تدريجيا، وزادت سلطة الدولة المركزية. ووفقا للبعض، فقد كان هذا إجراءًا ضروريا لمنع انهيار الدولة، إلا أن هذا الإجراء كما أنه لم يجدِ نفعًا في ضمان وحدة أراضي الدولة العثمانية كذلك استلزمت إدارةُ الدولة من مركز واحد الفشل الذريع للمركز في حل المشاكل المحلية.
وبالتالي ارتفعت حالة عدم الرضا المحلي بشكل كبير. على سبيل المثال، كان من المتوقع أن تفضل بعض المناطق البلقانية الدرع الواقي للإمبراطورية العثمانية لفترة من الوقت في حالة زيادة الميزات الإدارية اللامركزية والفدرالية في البلقان، لكن هذا لم يحدث، فمع جمع القوة المركزية كل السلطات في يديها، انخفضت المرونة في الدولة وتشكل هيكلٌ أكثر هشاشة.
في عشرينيات القرن الماضي، النخب العثمانية، وخاصة النخب العسكرية، التي واجهت “متلازمة اتفاقية سيفر” (وهي اعتقاد شائع بأن بعض القوى الخارجية، وخاصة الغرب، تتآمر لإضعاف تركيا وتقسيمها) فضلت تأسيس جمهورية في عام 1923 تقوم على مركزية الدولة أو الدولة المركزية التي تجمع كل السلطات في يديها. المبدأ الأساسي لهذا الشكل من الدولة هو سيطرة الإدارة المركزية على الإدارة المحلية، ومن أجل تحقيق ذلك، كان لا بد من حل الهويات والولاءات المحلية بالكامل في النخب التي جاءت إلى الحكومة المركزية. لذا نرى أن أبواب الدولة والمناصب الرسمية أوصدت في وجه بعض الشعوب والمجموعات الفكرية لفترة طويلة، وعلى وجه الخصوص الأكراد والعلويين واليساريين والإسلاميين والطورانيين. ولم ينجح أي من هذه الشعوب والمجموعات الانضمام إلى الأجهزة الإدارية والمؤسسة العسكرية إلا هؤلاء الذين نجحوا في تقمص “نموذج الإنسان المثالي” الذي كانت تقترحه الجمهورية الوليدة لمواطنيها.
ردود فعل الدولة الصارمة على عمليات الاختراق والتسلل ظهرت في ذلك العهد وتطورت آخذة أشكالا وأساليب مختلفة إلى يومنا هذا. وهكذا راح “الأكراد” ليحل محلهم “مواطنون منحدرون من أصول كردية”، -وهذا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أصبحت نظرة الدولة للقضية الكردية تتسم بالعقلانية نسبيا!- فالأصل لم يكن علامة تدل على هويتك وتعرّفك، بل كان مجرد عنصر يحدد من أين جئت أنت. فالمنحدرون من أصول كردية – في نظر الدولة -كانوا الأكراد الذين فقدوا روابطهم مع كرديتهم وتعرضوا للذوبان الثقافي كما ينبغي!
وكان العلويون مثلهم، حيث كان أفضل العلويين هم العلمانيين. لم يبق منهم على التصوف العلوي وتقاليدهم الدينية إلا جيل الأجداد والجدات بشكل عام، في حين أن الجيل الجديد فكان يتبنى الفكر الأتاتوركي أو اليسار الماركسي. العلويون كانوا يفضلون اليسارية المفرطة في أيام شبابهم، ثم يميلون إلى النظرة القائلة بأن مصطفى كمال أتاتورك هو زعيم الديمقراطية الوطنية الثورية، لينتهي بهم المطاف في السنوات المتأخرة من أعمارهم إلى الخط الكمالي المتطرف. بهذه الطريقة فقط احتجز العلويون لأنفسهم موقعا معينا في مؤسسات الدولة.
وهكذا كانت الدولة التركية دولة مركزية ومجهزة ضد عمليات التسلل والاختراق، فتفضيل الدولة الموحدة على الدولة الفيدرالية كان نابعا من قلق الحفاظ على السلطة المركزية، كانت النخب التركية السنية العلمانية تواصل بهذه الطريقة السيطرة على الدولة، فمبدأ “لا يمكن أن تكون الدولة ذات رأسين مختلفين” هو المنطق الرئيسي الذي يعتمد عليه مفهوم وخطاب “الكيان الموازي” للدولة.
كان الجيش هو المركز الأكثر رسوخا واستقرارا وصرامة للدولة، ويليه في ذلك الجهاز البيروقراطي المدني، مع أن الثاني كان أوهن في ذلك وأكثر مرونة من الأول. فقد كان الجيش هو الوحدة الأكثر حساسية في الدولة دوما، لأنه كان مكلفا بوضع الأمور في نصابها ومدارها المعتاد القديم إذا خرجت عن السيطرة. هذا كان نوعا من الدستور “غير المكتوب” الذي لا يحتاج إلى أن يكتب، حتى إنه كان فوق الدستور! هذه العقلية زعمت أن هناك ثوابت للدولة هي ضرورة وجودية لا يمكن تغييرها وتحويلها. فإذا كانت الدولة فتحت أبوابها لموظفين يتحلون بصفات أخرى غير مذكورة في عقيدة الدولة وفلسفتها أو وصلت مجموعة سياسية أخرى إلى الحكم فإن ذلك يعني أن الأمور قد خرجت عن مجراها!
هذه الدولة التي تصنع وتفرض نموذجًا واحدًا من الإنسان تعرضت بطبيعة الحال لعمليات الإغارة والاستيلاء من قبل مجموعات تنتمي إلى أفكار وأيديولوجيات مختلفة. ولأن الجمهورية التركية لم تستطع نشر ثقافتها السياسية على جماهير عريضة من خلال توزيع عادل لثروات البلاد فإنها توجهت لإنجاز ذلك عبر التلقين وزرع الأفكار في العقول والأساليب القمعية، مما جعلها أكثر إثارة للكره والاشمئزاز.
هذا الوضع دفع كل مجموعة لوضع استراتيجات في إطار “المبادئ التأسيسية للجمهورية التركية” من أجل التمكن من دخول مؤسسات الدولة. فمثلاً، ظهر نموذج ضابط عسكري يشرب الراكي والبيرة “تقية” من أجل الالتفاف والتغلب على قاعدة “عدم دخول المتدينين إلى الجيش”. لقد نظرت كثير من المجموعات إلى التوظف في مؤسسات الدولة كطريقة تضمن وجودها، لأن هذه المجموعات رأت في الدولة تهديدًا لوجودها بسبب مواقفها وممارساتها الإقصائية، وسعت لإزالة تهديدها من خلال التوظف في مؤسساتها؛ في حين أن البؤرة الصلبة للدولة اعتبرات دائمًا هذه المحاولات اختراقًا للدولة. وذلك على الرغم من أن الوظيفة العامة كانت حقا دستوريا لكل مواطن تركي تتوفر فيه الشروط الموضوعية. ولكن من يبالي بهذا الحق؟ لقد أشرتُ أعلاه إلى الدستور غير المكتوب الذي يعتبر فوق الدستور الشكلي المكتوب.
يسيطر اليوم على النظام في تركيا مجموعة من الإسلاميين الذين اعتبرتهم الدولة “الآخر” ذات يوم أيضًا، وقد حولتهم هذه الدولة وأعادت تصميمهم على شاكلتها مجددًا تمامًا مثل تحويلها واستيعابها المنحدرين من أصول كردية. فهل الإسلاميون يطالبون الآن بتحويل النظام؟ كلا، بل إنهم يحمون هذا النظام بالتعاون مع الدولة العميقة، في الواقع أن ما اتفق عليه هؤلاء هو حماية كل طرف مصالحه الخاصة، ولكن يعتبرهم الكثيرون وطنيين.
والآن بدأت بلديات حزب الشعب الجمهوري هي الأخرى تتعرض لاتهام “الدولة الموازية”، لأنها تؤكد ضعف الإدارة المركزية وتفضحها من خلال تقديم خدمات للمواطنين بدلاً منها أثناء انتشار فيروس كورونا، مما يشير إلى فراغ في السلطة والإدارة. وكما أن جماعة فتح الله كولن والليبراليين استهدفتهم الدولة المركزية تحت إدارة الإسلاميين الفاشيين بحركة الفصل والاعتقال التعسفية لأنهم وقفوا إلى جانب التحقيقات القضائية الرامية إلى الكشف عن جميع المتورطين في الفساد، كذلك تواجه البلديات المعارضة اليوم مصيرًا مشابهًا بسبب التهمة ذاتها، لأنها كشفت عن عورات وسوآت الدولة وفشلها في مكافحة الوباء العالمي.
أركان النظام الحالي ترسخت عقب ما يسمى “اتفاقية يني كابي” التي شارك فيها جميع الأحزاب، بما فيها حزب الشعب الجمهوري، من أجل التضامن ضد محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016، الرئيس أردوغان هو الذي وظف حتى المعارضين في إنشاء هذا النظام ويقول لهم الآن: “لا تشاغبوا.. فنحن جميعًا من أسسنا هذا النظام!”
إذا كانت هناك إمكانية للتخلص من هذه الأوضاع الراهنة أو إذا كان ضوء في نهاية النفق المظلم فعلينا أن ندافع عن ضرورة تأسيس دولة لامركزية قبل كل شيء حتى عن الديمقراطية! يجب إقامة توازن من خلال توزيع القوى والسلطات بين مركز فيدارالي وعدة وحدات محلية، إلى جانب دولة مركزية يكون الولاء فيها للأهلية والكفاءة لا لشيء آخر. هذه الدولة ستكون ملكًا لجميع المواطنين من دون استثناء أحد. وفي هذه الحالة فإن الدولة لن تكون قابلة للاختراق والتسلل؛ لأنها ستكون للجميع. كل مواطن سيكون له الحق في الانضمام إلى القطاع العام والخدمة العامة، والوطنية ستصبح حينها الدفاع عن الدستور والقانون والحريات المكفولة بهما. فهذا هو المطلوب.
مع أنني لا أتوقع ذلك إلا أن أمنيتي هي أن تستخرج جميع الأحزاب شبه المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، الدروس اللازمة من تهمة “الدولة الموازية” التي تواجهها اليوم، وتمارس النقد الذاتي، وتسعى إلى ترميم النظام الدستوري من خلال الدفاع عن الحقوق، خاصة حقوق ضحايا مقصلة حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان بحجة التصدي للانقلابيين ثم استخدمها كعصا غليظة لضرب معارضيه أو المختلفين معه من المدنيين.
–