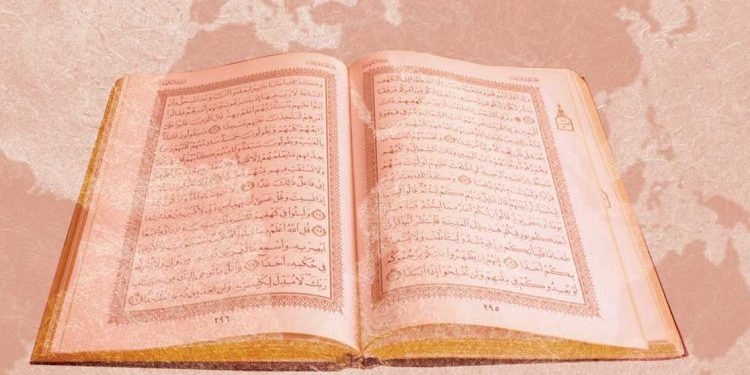بقلم/ الشاهد البوشيخي
إذن لابد أن تقوم الأجيال عبر العصور حتى تقوم الساعة بنفس وظيفته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقع العلي ليست الأمة الآن فيه، فكيف تنتقل من هذا الواقع الأليم إلى ذلك الموقع العلي؟ ههنا أمامنا كتاب ربنا، فيه كل الهدى اللازم لهذا الانتقال الفردي والجماعي، على مستوى الأقطار وعلى مستوى الأمة جمعاء. ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾(الإسراء:9)، هذا هو الهدى فيجب اتباعه ليحصل الاهتداء ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ﴾(المائدة:15-16)، أما الذي لا يتبع فلا هداية له.
الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى هذا الهدى لتنتقل على كل المستويات، -خاصة على مستوى التفكير- تفكير الأفراد وتفكير الجماعات وتفكير الأمة جمعاء. إنها في حاجة إلى هذا القرآن لتنتقل من مستوى الاهتمام بما هي خائضة فيه الآن من التفاهات، وترتقي إلى المستوى الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من حوله، فتجعل الآخرة هي المبتغى ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾(العنكبوت:64). فالدنيا ليست هي الحياة ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾(الفجر:23-24)، يوم يستيقظ حقا. نحن هنا الآن في وضع السكرة، ولابد من الاستيقاظ، والاستيقاظُ يقتضي أن نعلم علم اليقين أن هذه ليست هي الحياة، لأن الحياة الحقيقية لا موت فيها ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى﴾(الدخان:56) فالآخرة هي الحياة، وهي التي ينبغي أن تحركنا في كل صغيرة وكبيرة.
وعندما شخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم وضْع الأمة في مثل حالنا اليوم، شخصها بمرض اسمه “الوهن”، قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: “حب الدنيا وكراهية الموت” (رواه أبو داود). الارتباط بالدنيا والاقتصار بالهم على الدنيا، ابتغاء الدنيا وحبس كل الهموم والطاقات في تحصيل الدنيا والارتفاع فيها.. ليس هذا هو الوضع الصحيح، المسلمون في حقيقتهم آخرويون وليسوا دنيويين، قال الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ﴾(القصص:77)، فيما آتاك وكل ما آتاك.
لكن، إذا أردت أن تسرف وأن تشتط وتسير على غير الهدى الرباني، فابتعدت عن الدنيا ابتعادا كليا، إذّاك يقال لك: ﴿وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾(القصص:77)، أما الابتغاء فهو للدار الآخرة لا سواها. هذه نقطة تصحيحية في التفكير الكلي الضخم، لابد أن يصبح “التفكير” في منتهاه واضحا، وفي مبتدئه واضحا، وفي ارتباطاته، في علاقتنا بالله جل جلاله وبهداه الذي جاءنا. لابد أن يكون في غاية الوضوح، ذلك تصحيح التفكير.
ولابد أن يصحح أيضا “التعبير”، كما في حديث معاذ بن جبل المشهور حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟” فقلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: “كف عليك هذا”، قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: “ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم” (رواه الترمذي وابن ماجه). لو تأملنا في الآيات المتعلقة بهذا المجال مثل قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾(الإسراء:53)، أو في الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت” (متفق عليه)، إذا تأملنا قليلا في مثل هذا، أدركنا بوضوح أن المسلم يمثل محطة تصفية للنفايات القولية. فالمسلم لا يمكن أن يرسل إلا الحق والخير، أما ما كان شرا وما كان باطلا وما لم نعلم هل هو شر أم خير، وهل هو باطل أم حق، فهو أيضا يلحق بالباطل والخطأ.
لنتصور أن هذه الحقيقة يعيشها الفرد، وتعيشها الأسرة والجماعة، ويعيشها الإعلام والتعليم وتعيشها الأمة، إلى أي حد يقل الشر في التداول ويكثر الخير.
إن المسلم محطة تصفية، لا يسمح للشر بالمرور، وإن استقبله فهو لضرورة؛ لأن الله جل جلاله جعل أجهزة الاستقبال لا تغلق، ولكن أجهزة الإرسال تغلق، فيجب التحكم فيها، فيمكن للمسلم أن يستقبل الخير والشر، ولكن لا يرسل إلا الخير.
نحن بحاجة إذن إلى هذا الهدى المنهاجي أيضا في “التعبير”، ومثل ذلك وأهم منه وأعظم، تحتاج الأمة إليه في “التدبير” لأمور ثلاثة مهمة، أولها: “تيسير الذكر”. فلقد حملت هذه الأمة أمانة، ويجب أن تيسرها للناس، تحملها هي بجدارة ثم تبلغها للناس ميسرة، فقد يسر الله سبحانه وتعالى الذكر للذاكرين: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾(القمر:17)، وذلك لينتشر الهدى. وثانيها: “تعمير الأرض” وفق هذا الذكر نفسه. وثالثها: “تسخير الكون” وفق هذا الهدى أيضا. كل ذلك هو صلب “التدبير”. فأي فعل صدر من العبد يجب أن يحكمه هذا القرآن الكريم.
مفهوم الهدى المنهاجي
“الهُدى” مداره على الدلالة والبيان والإرشاد؛ هَداه يهديه: دلَّه بلطف كما عبر الراغب الأصفهاني قال: “الهداية هي الدلالة بلطف”، وليس بعنف، وهي التي تلائم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتلائم المرسلين وأتباعهم. فهذه الدلالة بلطف أو هذا البيان الرفيق أو هذا الإرشاد الحكيم، كل ذلك من محتويات الهدى بصفة عامة.
أما “المنهاج”، فهناك ثلاثة ألفاظ تستعمل فيه: “النهج” و”المنهج” و”المنهاج”، وكلها يقصد بها الطريق، لكن “المنهج” أغلب استعماله في الطريق الفكري، وأغلب استعمال “النهج” في الطريق مطلقا، وأغلب استعمال “المنهاج” في الطريق العملي الذي له أصل فكري، ولكن الذي هو في البؤرة في لفظة المنهج هو الطريق الفكري، أي الكيفية النظرية التي يتم وفقها الوصول إلى حقائق معينة. وأما “المنهاج” فهو الطريقة العملية التي يسار عليها للوصول إلى مقاصد بعينها.
فإذا ركبنا الأمر وقلنا “الهدى المنهاجي”، يصير الأمر تلقائيا أن المقصود به هو الطريقة المُثلى في “التفكير” وفي “التعبير” وفي “التدبير”. فإذا قلنا: “الهدى”، انصرف إلى هدى الله عز وجل ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى﴾(البقرة:120)، وحين نقول “الهدى المنهاجي في القرآن الكريم”، نقصد به “الطريقة المثلى في أداء الخلافة، وفي أداء العبادة، وفي أداء الشهادة”. فنحن المسلمين مطلوب منا الأداء العام الذي لجميع البشرية، وهو أداء وظيفة الخلافة، ومطلوب منا أداء وظيفة العبادة داخل إطار وظيفة الخلافة، ثم أداءُ وظيفة الشهادة داخل إطار الخلافة. فالعبادة هي الأخص. هذه الشهادة لها طريقة معينة يمكن التأهل لها، ويمكن أداؤها تبعا لذلك التأهل. فالطريقة المثلى التي يرشد إليها كتاب الله عز وجل، وبيانه الذي هو السنة الصحيحة، تلك الطريقة المثلى التي ترشد المسلمين خاصة والناس عامة إلى الأفضل والأقوم في كل المجالات، سواء في مجال التفكير أو مجال التعبير أو مجال التدبير، وهذا الأخير بجميع مستوياته أيضا: تيسيرا للذكر أو تعميرا للأرض أو تسخيرا للكون وما فيه من طاقات ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾(لقمان:20)، كل ذلك كامن في كتاب الله عز وجل، وعلى المسلمين استخراجه.
مصادر الهدى المنهاجي
وتتلخص في ثلاثة مصادر كبرى، وهي أولا: القرآن فهو الأصل لغيره، ثانيا: السنة التي هي بيان القرآن ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾(النحل:44)، ثالثا: السيرة النبوية. فعندنا ثلاثة مصادر هي: القصص القرآني والقصص الحديثي ثم السيرة النبوية.
هذه المصادر الثلاثة فيها يتركز الهدى المنهاجي، وإلا فهو موجود في كتاب الله عز وجل كله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وفي السيرة النبوية الصحيحة كلها كذلك. فالسيرة هي “الوجه العملي للقرآن مربوطا بالزمان”، أو هي “السنة المنظومة في الزمان”، فإذا كان ما في كتب الصحاح والسنن يمثل الإسلام في الوضع الأفقي، أي يستجيب للقضايا الفقهية والعقدية وغيرها، أي ما هو الإسلام؟ وما هو الإيمان؟ وما هو الإحسان؟ فذلك عرض للإسلام في الصورة التي انتهى إليها، لكن السيرة النبوية تعرض ذلك نفسه بطريقة تنمو وتتطور، منذ بدء نـزول القرآن إلى اكتماله. فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم بين ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾(العلق:1) وبين ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾(المائدة:3)، قاله بين لحظة بعثته صلى الله عليه وسلم وبين آخر نـزول للوحي. في تلك الفترة قال كل ما نجده في كتب السنة، لكن عبر زمان وعبر ظروف بعينها تطوَّر خلالها تطوُّرا؛ وكان يناظر إحلال القرآن الذي كان يتنـزل ويجعله واقعا في الحياة، التي كانت إذّاك تتشكل بحسب الهدى المنهاجي الذي يأتي به القرآن.
لكن الهدى المنهاجي يتركز أولا في القصص القرآني. لأن الله عز وجل قال لرسوله وللأمة جمعاء: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه﴾(الأنعام:90)، نحن -ونحن نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة- ليس لنا طلب غير طلب الهدى ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾(الفاتحة:6) أيّ صراط؟ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾(الفاتحة:7) هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، هم كما في الآية الأخرى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾(النساء:69)، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، رأسُهم وأئمتهم هم الأنبياء عليهم السلام. ولذلك قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾(يوسف:111). من هنالك ينبغي أن يستفاد الهدى المنهاجي. ففي كل قصة فوائد غزيرة، وفي مجموع القصص فوائد أغزر، وحين يرتبط ذلك بما هو بعده -مما هو آت- يصبح أعظم فائدة.
أيضا القصص الحديثي، فالنصوص الحديثية كلها مجال للهدى المنهاجي، لأن الحديث بيان للقرآن، ولكن الذي فيه التركيز أكثر لهذا الهدى هو الحديث الذي يشتمل على القصص والأمثال.
وأما المصدر الثالث، فهو السيرة النبوية، التي هي الإطار الزمني للقرآن الكريم مفرقا ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً﴾(الإسراء:106)، وهي الإطار الزمني أيضا لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة. فالسيرة هي قصة النبي الخاتم، قصة أعظم رسول وأعظم نبي وأعظم بشر. فقصته الكبرى توجد في السيرة النبوية. وإذا كانت قصص الأنبياء توجد في القرآن الكريم، وتوجد إشارات إليها وبيانات في السنة الصحيحة أيضا، فقصته صلى الله عليه وسلم موجودة في السيرة النبوية التي هي “الصدى العملي الأعلى للقرآن الكريم”. هذه الحقيقة تجعلنا ننظر إلى السيرة النبوية في علاقتها بالقرآن الكريم، نظرة جديدة مهمة في زماننا هذا، لأن واقع الأمة لابد من العمل على الانتقال منه إلى الموقع الذي يريد الله منها أن تكون فيه، وهو موقع الشهادة على الناس. هذا الانتقال أكبر مرشد له وأكبر هدى منهاجي يمكن أن نستخلصه له هو في تلك السيرة مربوطةً بالقرآن الكريم، أو من القرآن الكريم مربوطا بالسيرة؛ لأن كثيرا من وقائعها موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالحياة الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحياة العامة في المرحلة المكية والمرحلة المدنية كلها مفصلة في القرآن الكريم، وفي بعض الأحيان أكثر مما هي مفصلة في السيرة نفسها. فلا يمكن دراسة السيرة النبوية بمعزل عن القرآن، ولا يمكن دراسة القرآن -من هذه الزاوية- بمعزل عن السيرة النبوية.
لوازم استنباط الهدى المنهاجي
إن استنباط الهدى المنهاجي أمر يسير لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه، لكنه من حيث الإنجاز هو أمر متقدم، يأتي بعد قراءة القرآن وتلاوته وفهمه والعمل به، وبعد ذلك يأتي استنباط الهدى منه. وللقيام بهذا الاستنباط هناك شروط:
الشرط الأول: إتقان ما يلزم لفهم القرآن، بدءاً باللسان. واللسان في القرآن هو اللغة ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾(الشعراء:192-195)، ففهمُ أيّ نص كان قرآنا أو غير قرآن يحتاج إلى التمكن من “المقام”، والتمكن من “المقال”، أي يحتاج إلى ما يلزم لفهم هذا النص من علوم المقام وعلوم المقال. لابد من إتقان اللغة العربية، فمن لا يتقن اللغة العربية محال بينه وبين استنباط هذا الهدى. فلابد من التمكين للغة العربية في مختلف المجالات، لابد من التمكين لها بقوة في التعليم وفي الإعلام وفي الإدارة وفي الحياة العامة، لابد من إيجاد مناخ لغوي، بل مستوى لغوي عربي عام يؤهل الإنسان لتلقي القرآن، ويحضره للمراحل القادمة لاستنباط الهدى من القرآن. هذه نقطة في غاية الأهمية والخطورة في الأمة اليوم. فعلى المسلمين أن يفقهوا الخطر وأن يكونوا في مستوى التحدي في المجال اللغوي، هذا عن المقال.
أما عن المقام فيجب أن نعلم أن الذي يتكلم بهذا القرآن هو رب العالمين، فالقرآن الكريم كلام الله عز وجل، وليس كلام أي أحد، وفيه دليله من مثل قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾(العنكبوت:51). اعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرفوا القرآن، ستجدون بوضوح أنه لا يمكن أن يكون القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون كلام العرب جميعا شعراء وخطباء في ذلك العصر ولا فيما تلاه، ولا يمكن أن يكون كلام أمة أخرى بالأولى. فواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق نطقين: ينطق نطقا اسمه القرآن، وينطق نطقا اسمه السنة، اقرأ هذا واقرأ هذا، وستجد الفرق كبيرا بين الكلامين. قارن القرآن بصحيح البخاري أو بصحيح مسلم، تجد أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام الله عز وجل، له بناء خاص جزئي وكلي، فكتاب الله عز وجل من حيث البناء له مقدمة هي الفاتحة، وله خاتمة هي سورة الإخلاص والمعوِّذتين، وله بناء معين في أقسامه الأربعة: من السبع الطوال إلى المئين والمثاني فالمفصل، ولكل جزء منه وضع خاص. فهذا أمر لابد من اليقين فيه من أن الذي يتكلم هو الله جل جلاله، إذ لابد لفهم الخطاب فهما صحيحا أن يُعلم مَن الذي يتكلم به، من المخاطِب؟ وأن يُعلم أيضا من المخاطَب؟ سواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الفترة بكاملها، من هم العرب إذّاك؟ ما مكة؟ ما المدينة؟ ما أولئك الناس؟ كيف كان حالهم؟ وكيف هم؟ وكيف هي عادتهم في الخطاب؟ لابد من معرفة هذا المقام، ومن معرفة طبيعة العلاقة، وكل ما كانوا عليه. فهذه الأمور مما يدخل أحيانا في علوم القرآن بصفة عامة، خصوصا ظروف النـزول وما يتصل بالنـزول، وما يتصل بالتدوين، كل ذلك لابد من العلم به لتيسير هذه الخطوة.
والشرط الثاني: الإيمان وارتداء لباس القرآن، وقد عبرت باللباس لأن الله تعالى قال: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾(الأعراف:26). لأن القرآن خُلُق، “كان خلقه القرآن” صلى الله عليه وسلم، كما أجابت أم المومنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه مسلم). والتقوى لباس يُلبس، بمعنى أنه يجب أن يكون ظاهرا في لسان العبد وفي عينه وفي أذنه وفي قلبه، وفي كل شيء من جوارحه. فلابد من الإيمان، لأن الله تعالى قال: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾(فصلت:44). فلا يسمعون إذ لا صلة لهم بالقرآن، فالذي لا يؤمن بالقرآن لا يمكن أن يفهم القرآن، ولذلك لا يمكن أن يؤخذ عنه علم القرآن. والذي لا يعمل بالقرآن أيضا لا يمكن أن يؤخذ منه لا القرآن ولا علم القرآن. هذا العمل هو الذي يعطي النور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾(الحديد:28). فهذا النور لا يكون بغير التقوى، ولذلك كان الإيمانُ بالقرآن والعمل بالقرآن شرطا في الفهم السليم للقرآن.
والشرط الثالث: هو فقه حاجة الأمة في هذا الزمان، فالذي يتصدى لاستنباط الهدى المنهاجي لا يكفيه أن يكون عليما بالعربية، عليما بعلوم القرآن، مؤمنا بالقرآن، بل لابد أن يكون مفقّها في ظروف زمانه، فقيها في حاجات الأمة اليوم، يعاني أحوال الأمة ويعرف وضعها أين هي؟ وما حالها؟ وما الذي تحتاج إليه الآن؟ لابد أن يفقه هذا. وهذا يقتضي “المعاصرة التامة والمعايشة التامة لزمانه”، لأن عملية تنـزيل النص على الواقع تتأثر عمليا بذلك. فالواقع لابد أن يُعرف لينـزَّل عليه القرآن التنـزيل الصحيح. زيادة على أنه مهم ليكون حلا للمعضلات والمشكلات، وليكون طريقا فعلا إلى الصعود لتصبح الأمة -عمليا- واحدة، وتصبح شاهدة، وتصبح رائدة. هذا مطلوب منا اليوم، مطلوب أن نسير في هذا الطريق حتى تصبح الأمة واحدة. والأمة في أصلها واحدة، ويجب أن تعود يوما ما واحدة، لابد أن تعود بجهد المسلمين جميعا حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، لابد أن يتعاونوا على هذا البر وعلى هذا التقوى، لكي تعود الأمة واحدة، ثم لكي تعود شاهدة، أي مؤهلة فعلا للشهادة على الناس، ولكي تعود رائدة لسواها في كل المجالات.
التركيز في الدرس القرآني على الهدى المنهاجي
عندنا في الدرس القرآني ثلاث علاقات: علاقة بتراثنا القرآني، وعلاقة بحاضرنا اليوم، وعلاقة بمستقبلنا.
ففي الأولى: ينبغي أن نركز على هذا الهدى المنهاجي لدى علمائنا، سواء في التفاسير أو في غيرها، يجب أن نبحث هناك وننقب عن هذا النوع الذي يمكن أن نستفيد منه اليوم. ويدلنا الدلالة الصحيحة على كيفية النهوض من جديد، وكيفية العود إلى الصراط المستقيم، إلى الوضع الصحيح، إلى الموقع العلي. هذا الذي ينبغي أن يكون في البؤرة.
وفي الثانية: يجب أن يكون التركيز على الهدى المنهاجي في معالجة أدواء الحاضر ومعضلاته. فالذين يبحثون في الأمة، والذين يفكرون، والذين يجتمعون على الخير أو يتشاورون، كل مَن فكّر وحَمَل همّ الأمة واتجه إلى أن يحل معضلة من معضلاتها أو يعالج داءً من أدوائها، يجب أن يعالجه أولا في ضوء ما استخلصه من كتاب الله عز وجل، من هذا الهدى الذي يلزم لمعالجة هذا الداء، بمعنى أن لا نعالج أدواء الحاضر بالهدى الغربي أو الهدى الشرقي، يجب أن نعالج أدواءنا بالهدى القرآني الذي هو هدى الله أما ما جاء عن سواه من الفهوم التي للبشر -مهما بلغت منـزلتهم ودرجتهم- فلا يستطيعون أن يصفوا الأدوية الكافية الشافية؛ لأنهم لا يعلمون كل شيء، لا يعلمون الغد ولا الحاضر ولا الماضي، بينما الله عز وجل يعلم السر وأخفى ﴿أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾(الملك:14). ولذلك فالدراسات أو البحوث أو المؤتمرات وكل الجهود يجب أن تركز على هذا الأمر.
ونفس الشيء في علاقتنا بالمستقبل، وذلك إذا استشرفنا المستقبل لا نستشرفه بناء على أفكار وعلى تخرصات، وإنما نستشرفه بناء على هدى منهاجي استنبطناه من كتاب الله عز وجل لنبني غدنا على أساس متين، موصولا بحاضرنا وبماضينا، لا قطيعة فيه ولا انبتات، وهو على الهدى الرباني الذي أراد الله عز وجل؛ لأن عز هذه الأمة هو في دينها، فإذا فرّطت في دينها ضاع عزها كما نراه اليوم. وإن هذه الأشكال من الخلل التي نراها نحن، أو يراها غيرنا من الخارج، ويسمونها بأسماء، إنما هي نتائج لغياب هذا الهدى. فنحن الآن لا نعلِّم الأمة القرآن، أوَ نستطيع أن ندعي هذا الادعاء؟! التعليم عندنا اليوم لا يجاوز أربعة أحزاب فقط في المغرب، وهي تُعطى في المرحلة الابتدائية حيث الطفل لا يستطيع أن يستفيد شيئا من هذا الذي نتحدث عنه، فهل ستة وخمسون حزبا ليست من القرآن؟! هل يوجد شيء أهم في حياة الأمة من القرآن حتى نقدمه على القرآن؟! هل يوجد؟ كلا طبعا!.. فيجب أن يصبح القرآن هو الأساس في التعليم وفي بناء الشخصية في الأمة، هذه نصيحة لله تعالى، وحقيقة نعلنها ونسرها ونجهر بها، هذا عين الحق الذي يجب أن يتبع.
إن هذا الاستشراف لابد أن يسهم ويتعاون عليه التعليم بالدرجة الأولى، والبحث العلمي والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة. والطريق هو أن يتجه الجميع نحو قبلة واحدة، هي التركيز على القرآن الكريم لاستفادة ما ينبغي الاستفادة منه، والتركيز على الوحي جملة بما فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتركيز على الذين استنبطوا من ذلك الهدى ما استنبطوا، مما ينفعنا مما أشرنا إليه في علاقتنا بالماضي، كل ذلك نستفيد منه جميعا ونتجه إليه جميعا. فالإدلاجَ الإدلاج، وعند الصباح يحمد القوم السرى..!