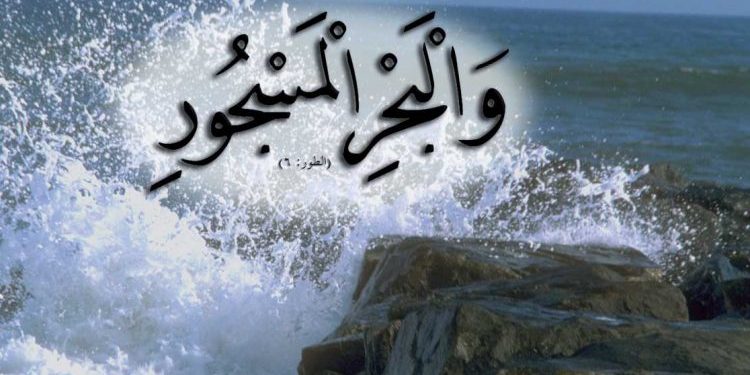بقلم/ زغلول النجار
البحر المسجور: المملوء بالماء والمكفوف عن اليابسة
الأرض هي أغنى كواكب المجموعة الشمسية بالماء الذي تقدر كميته بحوالي 1360 إلى 1385 مليون مليون كيلو متر مكعب، وهذا الماء قد أخرجه ربنا سبحانه وتعالى كله من داخل الأرض على هيئة بخار ماء اندفع من فوهات البراكين، وعبر صدوع الأرض العميقة ليصادف الطبقات العليا الباردة من نطاق التغيّرات الجوية والذي يمتد من سطح البحر إلى ارتفاع حوالي ستة عشر كيلو مترا فوق خط الاستواء، وحوالي العشرة كيلو مترات فوق قطبي الأرض، وتنخفض درجة الحرارة في هذا النطاق باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ستين درجة مِئويّة تحت الصفر في قمته.
وهذا النطاق يحوي حوالي ثلثَي كتلة الغلاف الغازيّ للأرض والمقدرة بأكثر قليلا من خمسة آلاف مليون مليون طن، وهو النطاق الذي يتكثف فيه بخار الماء الصاعد من الأرض، والذي تتكون فيه السحب، وينـزل منه كلّ من المطر والبرد والثلج، وتتم فيه ظواهر الرعد والبرق، وتتكون العواصف والدوامات الهوائية وغير ذلك من الظواهر الجوّية. ولولا تبرد هذا النطاق مع الارتفاع ما عاد إلينا بخار الماء الصاعد من الأرض أبدا. وحينما عاد إلينا بخار الماء مطرا وثلجا وبردا، انحدر على سطح الأرض ليشقّ له عددا من المجاري المائية، ثم فاض إلى منخفضات الأرض الواسعة ليكوّن البحار والمحيطات. وبتكرار عملية التبخر من أسطح تلك البحار والمحيطات ومن أسطح اليابسة بما عليها من مختلف صور التجمّعات المائية والكائنات الحية بَدَأت دورة المياه حول الأرض، من أجل التنقية المستمرة لهذا الماء وتلطيف الجوّ وتفتيت الصخور وتسوية سطح الأرض وتكوين التربة وتركيز عدد من الثروات المعدنية، وغير ذلك من المهام التي أوكلها الخالق لتلك الدورة المعجزة التي تحمل 380,000 كيلو متر مكعب من ماء الأرض إلى غلافها الجوي سنويا، لتردها إلى الأرض ماءً طهورا؛ منها 320,000 كيلو متر مكعب تتبخر من أسطح البحار والمحيطات، و 60,000 كيلو متر مكعب من أسطح اليابسة؛ يعود منها 284,000 كيلو متر مكعب إلى البحار والمحيطات، 96,000 كيلو متر مكعب إلى اليابسة التي يفيض منها 36,000 كيلو متر مكعب من الماء إلى البحار والمحيطات، وهو نفس مقدار الفارق بين البخار والمطر من وإلى البحار والمحيطات.
هذه الدورة المحكمة للمياه حول الأرض أدّت إلى خزن أغلب ماء الأرض في بحارها ومحيطاتها حوالي 97,2%، وإبقاء أقله على اليابسة حوالي 2,8%. وبهذه الدورة للماء حول الأرض ملحت ماء البحار والمحيطات، وبقيت نسبة ضئيلة على هيئة ماء عذب على اليابسة (2,8% من مجموع كم الماء على الأرض)؛ وحتى هذه النسبة الضئيلة من ماء الأرض العذب قد حبس أغلبها (من 2,052% إلى 2,15%) على هيئة سُمك هائل من الجليد فوق قطبَي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي مختزَن في الطبقات المسامية والمنفذة من صخور القشرة الأرضية على هيئة ماء تحت سطحي (حوالي 0,27% إلى 0,5%)، وفي بحيرات الماء العذب (حوالي 0,33%)، وعلى هيئة رطوبة في تربة الأرض (من0,01% إلى 0,18%)، ورطوبة في الغلاف الغازي للأرض تتراوح بين (0,0001% إلى 0,036%)، وما يجري في الأنهار والجداول (حوالي 0,0047%).
وتوزيع ماء الأرض بهذه النسب التي اقتضتها حكمة الله الخالق قد تم بدقة بالغة بين البيئات المختلفة بالقدر الكافي لمتطلبات الحياة في كل بيئة من تلك البيئات، وبالأقدار الموزونة التي لو اختلّت قليلا بزيادة أو نقص لغمرت الأرض وغطت سطحها بالكامل، أو انحسرت تاركة مساحات هائلة من اليابسة، ولقصرت دون متطلبات الحياة عليها.
ومن هذا القبيل يحسب العلماء أن الجليد المتجمّع فوق قطبَي الأرض وفي قمم الجبال المرتفعة فوق سطحها إذا انصهر (وهذا لا يحتاج إلا إلى مجرّد الارتفاع في درجة حرارة صيف تلك المناطق بحوالي خمس درجات مئوية) فإنّ كم الماء الناتج سوف يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات إلى أكثر من مائة متر فيغرق أغلب المناطق الآهلة بالسكان والممتدة حول شواطئ البحار والمحيطات. وليس هذا من قبيل الخيال العلمي، فقد مرت بالأرض فترات كانت مياه البحار فيها أكثر غمرا لليابسة من حدود شواطئها الحالية، كما مرت فترات أخرى كان منسوب الماء في البحار والمحيطات أكثر انخفاضا من منسوبها الحالي مما أدى إلى انحسار مساحة البحار والمحيطات وزيادة مساحة اليابسة. والضابط في الحالين كان كمّ الجليد المتجمع فوق اليابسة، فكلما زاد كمّ الجليد انخفض منسوب الماء في البحار والمحيطات فانحسرت عن اليابسة التي تزيد مساحتها زيادة ملحوظة، وكلما قلّ كمّ الجليد ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات وطغت على اليابسة التي تتضاءل مساحتها تضاؤلا ملحوظا.
من هنا كان تفسير القَسَم القرآني بـ”البحر المسجور” بأن الله تعالى يمن علينا -وهو صاحب الفضل والمنة- بأنه ملأ منخفضات الأرض بماء البحار والمحيطات، وحَجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة منذ خلق الإنسان، وذلك بحبس كمّيات من هذا الماء في هيئات متعددة أهمها ذلك السمك الهائل من الجليد المتجمع فوق قطبي الأرض وعلى قمم الجبال، والذي يصل إلى أربعة كيلومترات في قطب الأرض الجنوبي، وإلى ثلاثة آلاف وثمانمائة من الأمتار في القطب الشمالي، ولولا ذلك لغطّى ماء الأرض أغلب سطحها، ولَما بقيت مساحة كافية من اليابسة للحياة بمختلف أشكالها الإنسانية والحيوانية والنباتية وهي إحدى آيات الله البالغة في الأرض، وفي إعدادها لكي تكون صالحة للعمران.
من هنا كان تفسير القَسَم بـ”البحر المسجور” بمعنى المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة ينطبق مع عدد من الحقائق العلمية الثابتة التي تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، وتشهد لسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة.
البحر المسجور: القائم على قاع أحمته الصهارة الصخرية المندفعة من داخل الأرض
في العقود المتأخرة من القرن العشرين تم اكتشاف حقيقة تمزق الغلاف الصخري للأرض بشبكة هائلة من الصدوع العملاقة المزدوجة والتي تكون فيما بينها ما يعرف باسم أودية الخسف أو الأغوار، وأن هذه الأغوار العميقة تحيط بالكرة الأرضية إحاطة كاملة، ويُشبّهها العلماء باللحام على كرة التنس (مع فارق التشبيه)، وتمتد هذه الأغوار في كافة الاتجاهات لعشرات الآلاف من الكيلو مترات، ولكنها تنتشر أكثر ما تنتشر في قيعان محيطات الأرض، وفي قيعان عدد من بحارها، ويتراوح عمق الصدوع المشكلة لتلك الأغوار بين 65 كيلومترا، و 70 كيلومترا تحت قيعان البحار والمحيطات، وبين100 و150 كيلومترا على اليابسة (أي في صخور القارات)، وتعمل على تمزيق الغلاف الصخري للأرض بالكامل، وتقطيعه إلى عدد من الألواح الصخرية التي تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة يسمّيه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، وهو نطاق لَدِن، عالي الكثافة واللزوجة، تتحرك بداخله تيارات الحمل من أسفل إلى أعلى حيث تتبرد وتعاود النـزول إلى أسفل، وهي بتلك الحركة الدائبة تدفع بكل لوح من ألواح الغلاف الصخري للأرض إلى التباعد عن اللوح المجاور في أحد جوانبه (في ظاهرة تسمي ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات)، ومصطدما في الجانب المقابل باللوح الصخري المجاور ليكون سلسلة من السلاسل الجبلية، ومنـزلقا عن الألواح المجاورة في الجانبين الآخرين.
وباستمرار تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض تتّسع قيعان البحار والمحيطات باستمرار عند خطوط التباعد بينها، وتندفع الصهارة الصخرية بملايين الأطنان في درجات حرارة تتعدى الألف درجة مِئوية لتساعد على دفع جانبي المحيط يمنة ويسرة، وتملأ المسافات الناتجة بالصهارة الصخرية المندفعة من باطن الأرض على هيئة ثورات بركانية عارمة، تحت الماء، تسجر قيعان جميع محيطات الأرض، وقيعان أعداد من بحارها، وتجدد مادتها الصخرية باستمرار.
وقد أدى هذا النشاط البركاني فوق قيعان كل المحيطات، وفوق قيعان عدد من البحار النشطة إلى تكون سلاسل من الجبال في أواسط المحيطات تتكون في غالبيتها من الصخور البركانية، وقد ترتفع قممها في بعض الأماكن على هيئة أعداد من الجزر البركانية من مثل جزر كل من أندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، اليابان، هاواي، وغيرها.. وفي المقابل تصطدم ألواح الغلاف الصخري عند حدودها المقابلة لمناطق اتساع قيعان البحار والمحيطات، ويؤدي هذا التصادم إلى اندفاع قيعان المحيطات تحت كتَل القارات وانصهارها بالتدريج مما يؤدي إلى تكون جيوب عميقة عند التقاء قاع المحيط بالكتلة القارية تتجمع فيها كميات هائلة من الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة التي تطوى وتتكسر لترتفع على هيئة السلاسل الجبلية على حوافّ القارات من مثل سلسلة جبال الإنديز في غربي أمريكا الجنوبية، وهنا يستهلك قاع المحيط بالتدريج تحت الكتلة القارية، وإذا توقفت عملية توسع قاع المحيط فإن هذا القاع قد يستهلك بأكمله تحت القارة مما يؤدي إلى تصادم قارتين ببعضهما. وينشأ عن هذا التصادم أعلى السلاسل الجبلية من مثل جبال الهيمالايا التي نتجَتْ عن اصطدام الهند بالقارة الأسيوية بعد استهلاك قاع المحيط الذي كان يفصل بينهما بالكامل في أزمنة أرضية سحيقة.
ويصاحب كلاًّ من عمليتَي توسع قاع المحيط في محوره الوسَطي، واصطدامه عند أطرافه عددٌ من الهزّات الأرضية، والثورات والطفوح البركانية.
ويبلغ طول جبال أواسط المحيطات أكثر من أربعة وستين ألفًا من الكيلومترات في الطول، بينما يبلغ طول الصدوع العميقة التي اندفعت منها الطفوح البركانية لتكون تلك السلاسل الجبلية في أواسط المحيطات أضعاف هذا الرقم. وتتكون هذه السلاسل أساسا من الصخور البركانية المختلطة بالقليل من الرسوبيات البحرية، وتحيط كل سلسلة من هذه السلاسل المندفعة من قاع المحيط بواد خسيف (غور) مكوّن بفعل الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخريّ للأرض بعمق يتراوح بين خمسة وستين كيلو مترا وسبعين كيلو مترا ليخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل ويصل إلى نطاق الضعف الأرضي الذي تندفع منه الصهارة الصخرية بملايين الأطنان في درجة حرارة تزيد عن ألف درجة مئوية لتسجر قيعانَ كل محيطات الأرض، وقيعانَ عدد من بحارها النشطة باستمرار.
وهذه الصدوع العملاقة التي تمزق قيعان كل محيطات الأرض، وقيعان عدد من بحارها (مثل البحر الأحمر) توجد أيضا على اليابسة، ولكن بنسب أقل منها فوق قيعان البحار والمحيطات. وتعمل على تكوين عدد من الأغوار (الأودية الخسيفة) والبحار الطولية (من مثل أغوار شرقي أفريقيا والبحر الأحمر) التي تعمل على تفتيت الكتل القارية باتساعها التدريجي لتتحول تلك البحار الطولية مثل البحر الأحمر إلى بحار أكبر ثم إلى محيطات تفصل بين الكتلة القارية التي كانت متصلة على هيئة قارة واحدة. وتحاط تلك الخسوف القارية العملاقة بعدد من القمم البركانية السامقة من مثل جبل “أرارات” في شرقي تركيا، ومخروط بركان “إتنا” في شمال شرقي صقلية، ومخروط بركان “فيزوف” في خليج نابولي بإيطاليا، وجبل “كيليمنجارو” في تنجانيقا (5900 متر)، وجبل “كينيا” في جمهورية كينيا.
بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار -بالأدلة المادية الملموسة- أن كل محيطات الأرض (بما في ذلك المحيطان المتجمدان الشمالي والجنوبي)، وأن أعدادا من بحارها (من مثل البحر الأحمر)، قيعانها مسجرة بالصهارة الصخرية المندفعة بملايين الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي، وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسا في قيعان البحار والمحيطات، وأن كمّ المياه في تلك الأحواض العملاقة -على ضخامته- لا يستطيع أن يطفيء جذوة الصهارة الصخرية المندفعة من داخل الأرض إطفاء كاملا، وأن هذه الجذوة على شدة حرارتها (أكثر من ألف درجة مئوية) لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل، وأن هذا الاتزان الدقيق بين الأضداد من الماء والحرارة العالية هو من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء في زماننا، وهي حقيقة لم يتمكن الإنسان من اكتشافها إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين.
ومن الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -هذا النبي الأمي الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى أعماق البحار- قال في حديث شريف: «لا يَركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإنّ تحتَ البحر نارا، وتحت النار بحرا» (سنن أبي داود). وجاء الحديث في مصنف ابن أبي شيبة بالنص التالي: «إن تحت البحر نارا، ثم ماء، ثم نارا».
ويعجب الإنسان المتبصر لهذا السبق في كل من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الأرض التي لم يتوصل الإنسان إلى إدراكها إلا في نهايات القرن العشرين. هذا السبق الذي لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدرا غير الله الخالق الذي أنزل هذا القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وعلّم هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم من حقائق هذا الكون ما لم يكن لأحد من الخلق إلمام به قبل العقود الثلاثة المتأخرة من القرن العشرين، لكي تبقى هذه الومضات النورانية في كتاب الله، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شهادات مادية ملموسة على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي حفظه سبحانه وتعالى على مدى أربعة عشر قرنا أو يزيد، وإلى قيام الساعة بنفس لغة الوحي (اللغة العربية) كلمة كلمة، وحرفا حرفا في صفائه الرباني، وإشراقاته النورانية، دون أدنى تغيير أو تبديل أو تحريف، وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان موصولا بالوحي ومعلَّما من قِبَل خالق السماوات والأرض.
فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه من قَبْل 1400 من السنين هذا القسَم القرآني بـ”البحر المسجور”؛ وسبحان الذي علم خاتم أنبيائه ورسله بهذه الحقيقة فقال قولته الصادقة: «إن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا»؛ وسبحان الذي أكد على صدق القرآن الكريم، وعلى صدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في كل ما رواه عن ربه، فأنزل في محكم كتابه قوله الحق: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد﴾ (فُصِّلَت: 53).