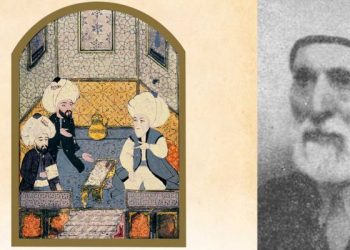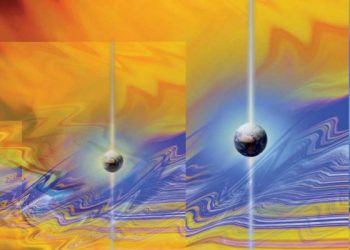بقلم/ فريد الأنصاري
(زمان التركية) – الجمالية” أو “علم الجمال” مصطلح يستعمل في الفكر المعاصر؛ للدلالة على تخصص من تخصصات العلوم الإنسانية التي تُعْنَى بدراسة “الجمال” من حيث هو “مفهوم” في الوجود، ومن حيث هو “تجربة” فنية في الحياة الإنسانية.
“فالجمالية” إذن؛ علم يبحث في معنى “الجمال” من حيث مفهومه وماهيته ومقاييسه ومقاصده. “والجمالية” في الشيء تَعْنِي أن “الجمال” فيه حقيقة جوهرية وغاية مقصدية، فما وُجِدَ إلا ليكون جميلا!(1) وعلى هذا المعنى انبنت سائر “الفنون الجميلة” بشتى أشكالها التعبيرية والتشكيلية.
ومصطلح “الجمالية” أو “علم الجمال” ترجمة لكلمة “استطيقا”، وهي كلمة ولدت في رحم الفلسفة الغربية من الناحية الاصطلاحية خلال القرن الثامن عشر الميلادي. فقد كان الفيلسوف “باومجارتن” سنة 1750م أول من سك هذا اللفظ، ثم انتقل استعماله إلى سائر الثقافات والعلوم الإنسانية كالأدب والفن.
إلا أن “الجمالية” من حيث هي مفهوم قديمة قدم الإنسان نفسه، وصاحبت الحضارات البشرية كلها بدون استثناء، واتخذت لها طابعا خاصا مع كل حضارة، كما كانت لها تجليات خاصة ومتميزة مع كل تجربة إنسانية مختلفة.(2) ولم تكن الحضارة الإسلامية بدعا من الحضارات الإنسانية جملة. ذلك أن “الجمال” في الإسلام أصل أصيل، سواء من حيث هو قيمة دينية: عَقَدِيَّةٌ وتشريعية، أو من حيث هو مفهوم كوني، وكذا من حيث هو تجربة وجدانية إنسانية. ومن هنا كان تفاعل الإنسان المسلم مع قيم الجمال ممتدا من مجال العبادة إلى مجال العادة، ومن كتاب الله المسطور إلى كتاب الله المنظور! مما خلد روائع من الأدب والفن التي أنتجها الوجدان الإسلامي في قراءته الراقية للكَوْنَيْن وسياحته الرائعة في العالَمَيْنِ: عالم الغيب وعالم الشهادة!
ولقد قاد الجهلُ بالتراث الإسلامي أو العمى الصليبي بعضَ فلاسفة الغرب إلى حصر التجربة الجمالية الإسلامية في مجال “الإدراك العقلي” دون “الإدراك الوجداني العاطفي”؛ واتهم التجربة الإسلامية بالفقر الفني والجمالي! فأقل ما يقال عن مثل هذا الاتهام أن صاحبه جاهل بحقيقة الإسلام وقيمه الجمالية من جهة، وبتجربة الأمة الإسلامية من جهة أخرى. أعني على المستوى الجمالي، في كل تجلياتها العربية وغير العربية: فارسيةً وهنديةً وتركيةً ثم مَالَوِيَّةً!
ولقد انبرى الفيلسوف الفرنسي المعاصر “إتيان سوريو” فيلسوف “الجمالية” وأستاذ علم الجمال في جامعة السربون بباريس(3) للدفاع عن هذه الحقيقة، ردا على بعضهم، لكنه مع ذلك لم يكن موفّقا كل التوفيق بسبب نقص المعطيات عنده عن قيم الجمال في الإسلام وعن تجربة المسلمين في ذلك المجال. يقول محيلا على اتهامات “بلزاك” في كتابه “الابن الملعون”: “لطالما قيل – وعلى غير وجهٍ من حق – إن الفن العربي قد كان فنا إدراكيا، لا يتوجه إلا إلى الفكر النظري المحض وليست له أية قدرة على الإثارة العاطفية!”.(4) ثم يستطرد بعد ذلك مدافعا عن الجمالية الإسلامية، بشواهد من جمالية العمران وفن العمارة بالبلاد العربية والإسلامية، لكن -مع الأسف- بتحليلات هي أقرب إلى الخرافة منها إلى المقاييس العلمية للجمال!
يقول: “إن هذا الرأي هو خاطئ تماما! والحقيقة هي ما ذهب إليه من قبل “غايي: Gayet” عندما تحدث في كتابه: “الفن العربي” عن المشاعر التي تثيرها -من وجهة نظر الجمالية العربية- المعطيات الهندسية لذلك الفن بتفاصيلها وأشكالها. ولذا فهو يقول بأن الدوائر الهندسية إذا كانت زواياها المتعددة مزدوجة، فإنها “توقظ في النفس مشاعر عميقة مطبوعة بطابع الصفاء العذب”، أما إذا كان عدد زواياها مفردا فإنها تبعث على “الحزن المبهم والقلق والاضطراب”. ويقول أيضا: “إن الصورة المتكونة من الجمع بين المربعات والمثمنات تبعث على فكرة السكون الأبدي، أما تلك التي تنبثق من الأشكال ذات الزوايا التسع فإنها توقظ الإحساس بسر مبهم مضطرب!”(5) كذا..!! والعجيب حقا هو كيف فهم “غايي” أن هذا التفسير الغريب للأشكال الهندسية هو “من وجهة نظر الجمالية العربية”، ثم كيف قبل منه الأستاذ “سوريو” هذا الهذيان ونقله على سبيل التبني في كتابه! لقد كان الأولى بغايي هذا أن يعرض أحواله المترددة ما بين “الصفاء العذب، والحزن المبهم، والقلق، والاضطراب” على طبيب نفسي خير له وللعلم من أن يفسر به أشكالا هندسية في صومعة، أو قبة مسجد، أو زوايا قلعة! لقد ضل كثير من مؤرخي الجمالية الغربيين الطريقَ إلى معالم الجمال الحق في الإسلام، وأخطؤوا مواطنَ علم الجمال في التجربة الإنسانية الإسلامية! فأنكرها بعضهم، وبقي البعض الآخر أسير الجدران والأسوار يحاول فك رموز النقوش وأشكال الزخارف، كما يحاول العالم الأركيولوجي فك رموز بدائية، في قطعة حجرية من عصور ما قبل التاريخ.
إن الجمالية الإسلامية تنبع أولا من حقائق الإيمان، إذْ تَشَكَّلَ الوجدانُ الإنساني فيها مما تلقاه من أنوار عن رب العالمين، الرحمن الرحيم، وما انخرط فيه بعد ذلك؛ سيرا إلى الله تعالى عبر أشواق الروح، مبدعا – باتباع تعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم – أروع ألوان التعبير الجمالي، من سائر أشكال العبادات والمعاملات والعلاقات، انطلاقا من حركته التعبدية في جمالية الصلوات ولوحاتها الحية الراقية وما يَنْظِمُهَا من عمران روحي ومادي، إلى هندسة المدائن الإسلامية بما تحمله من قيم روحية سامية، وقيم حضارية متميزة جدا، إلى سائر النشاط الإنساني الذي أبدعه المسلمون في علاقتهم بربهم وعلاقتهم بأنفسهم وبغيرهم، إلى علاقتهم بالأشياء المحيطة بهم، بدءً بالمسخَّرَات من الممتلكات والحيوان، إلى المحيط الكوني الفسيح، الممتد من عالم الشهادة حولهم إلى عالم الغيب فوقهم… كل ذلك تفاعل معه المسلم؛ فأنتج أروع الأدبيات التعبيرية والرمزية، مما لا تزال تباريحه المشوقة بالمحبة، من الترتيل إلى التشكيل تفيض على العالَم بالجمال والجلال أبداً.
إن العمارة الإسلامية – رغم ثرائها الجمالي الرفيع – هي آخر ما ينبغي الاشتغال به لمن أراد أن يدرس الجمالية الإسلامية في مصادرها الأولى. لأن حصون المدائن وجدرانها إنما هي التجليات المادية المعبرة عن أشواق الروح، الفياضة عبر القباب والمآذن مندفعة بقوة نحو السماء. وإنما هي صورة التعبير الرمزي عن معاني الاحتضان العاطفي وقيم الأخلاق الاجتماعية والحنان الرَّيان بما امتازت به من حياء وتستر وانحناءات، تتلوى أضلاعها الخفاقة بالمحبة بين الدروب، تسلك بالرجال والنساء مسالك الحشمة الرقيقة والوقار العالي، إلى المساجد وإلى الغرفات والشرفات الكاشفة الساترة… ثم تنشر أسرارها نقوشا وزخرفة تتبادل الأدوار مع أحرف الخط العربي بشتى أشكاله، في كلمات ناطقة حينا، وناظرة أحيانا أخرى… كلها تتدلى مثل العناقيد من بين الأقواس، تستقبل مواجيد المحبين وترد سلام المتبتلين، لتتوحد معهم في صلاة أبدية خالدة.
ولقد دَبَّجَ المسلمون في مصنفات المحبة والسلام تباريحَ الأشواق أنى مرساها، ووصفوا مقامات النور كيف مجراها، ورسموا كلمات الجمال بما لا قِبَلَ به لأحد من العالمين.(6)
وكأنما الفرق في “الجمالية” بين مفهومَيْها الغربي والإسلامي كالفرق بين الطبيعة والتمثال أو بين الحقيقة والخيال. ولم تكن الصورة التي يبدعها المسلم ثابتة قارة يأكلها البِلَى في متحف “اللوفر” أو غيره من متاحف العالم، ولكنها صورة حية يشكلها بإبداعه اليومي بين ركوع وسجود، وطواف وسعي، أو بين صوم وتبتل، وانقطاع يصله كليا بالملأ الأعلى… ثم مواجيد يتنفسها بعد ذلك كلماتٍ وكتاباتٍ ذات صورٍ الجمالُ فيها له روح، صور لا تبلى أبد الزمان: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح:29).
تلك صورهم الحية، فأين منها بسمة “الجوكاندا” المصطنعة الشاحبة، أو وجوه “بيكاسو” المتداخلة المتنافرة! هذه صور الجمال في الأدبيات الإسلامية ما تزال تتجدد عبر التاريخ أبدا، ولا يزال القارئ لها في كل مكان يشارك بمخيلته في إبداع الأشكال كما هو يريد، بحرية تتحدى آخر الصيحات في عالم الرسم والتشكيل. وليس عندهم صور ميتة يفرضها فنان على الناس فتستعبد مُخَيِّلَةَ الأجيال وتقتل إبداعهم. ومن هنا توجه الفن الإسلامي حضاريا – في الأعم الغالب – إلى الإبداع ضمن جمالية “التجريد”. والتجريد في الحقيقة إنما هو لغة الروح، وريشة الوجدان. يقول “إتيان سوريو”: “والحقيقة التي لا بد من التنويه بها كذلك، هي أن الروحية الإسلامية تحترس على الأخص من مخاطر الفن التجسيمي، وتجد لها ضمانات كبرى في استعمال الفن التجريدي. من هنا، ومن هذه الوجهة خصوصا، يجب تفسير الوضع الجمالي للفن الإسلامي من الناحية التجريدية. أضف إلى ذلك أن الفن التجريدي هو بالضبط الفن الذي يستجيب في العالم العربي لما تقتضيه الحاجة الجمالية اقتضاء شديدا ودقيقا”.(7)
إن لغة التجريد في الفن الإسلامي هي التي تصنع حركة الحياة الفعلية في المجتمع، حيث تتفتق جماليتُها المتجددة سلوكا حضاريا راقيا، وعلاقات اجتماعية مفعمة بالود والمحبة والسلام، تتضافر جميعها في نسيج عمراني يرقى إلى درجة المثال، وذلك بما يفيض من وجدان الإنسان المسلم من تباريح الإيمان وأشواق الروح.
وما قتل الفن الغربي شيء مثل الولع بسجن الإبداع في الصور الجامدة الثابتة، ولو في حركتها الوهمية الاصطناعية. وعليه فإن الوضع الفني في أوروبا قد وصل فعلا إلى الباب المسدود. يقول فيلسوف الجمالية المعاصر: “إذا أخذنا الفن أداة للحكم على الحاجات الجمالية لوقتنا الحاضر، نجدها قد أصيبت بتغييرات جذرية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم. فالزائر الذي يتجول في أرجاء متحف للفن الحديث، لو انتقل من قاعة تضم لوحات انطباعية إلى قاعة أخرى تضم لوحات حديثة من الفن التجريدي أو التجسيمي، لاجتاحه -ولا ريب- شعور بالانتقال من عالم إلى عالم آخر، وإحساس بالغربة عميق. ولنقابل المسألة هنا بكل حدتها، فلا نتردد بالقول بأن هذا الزائر نفسه (…) قد تسول له نفسه أن يتحدث عن خط انحداري ومسيرة تقهقرية في الفن”،(8) إلى أن يقول – بعد وصف مآل بعض أنواع الفن الأخرى – بحدة نقدية شديدة: “ولا شك في أن من يراقب هذا التبديل المفاجئ سيجد نفسه مدفوعا إلى القول بأن ما يسمعه ويشاهده ليس إلا رجعة إلى حالة من البدائية والتوحش”.(9)
إلا أنه لا بد من البيان أن معاني الجمال في الإسلام، من صفاء الروح، ومنازل الإيمان، وأحوال الإحسان، لم يستفد منها جمهور كبير من أبناء الصحوة الإسلامية المعاصرة لأسباب شتى، منها اشتهار نسبة بعض مفاهيمها وألفاظها إلى المتصوفة؛ فكان أن زهد كثير من الناس فيها بسبب ما خالط بعض كتبهم من شطحات.(10) وإنما هي عبارات قرآنية أو نبوية محضة. نعم، ربما اكتسبت في سياق الاستعمال التاريخي دلالات منحرفة في بعض الأحيان، فيكون الواجب هو تحريرها منها، لا إلغاءها والتنكر لها.
إنه ما ينبغي لذلك أن يعمينا عن جمال الدين، وإنما خاطبنا الله تعالى بالجمال، وأمرنا أن نرحل إلى منازله العليا، ونسير إليها سيرا لا يفتر ولا ينقطع حتى يدركنا اليقين. لا ينبغي للمؤمن الكَيِّسِ الفَطِنِ أن تعميه غلطات بعض الناس – مهما قبحت – عن محاسن الدين، فيقنع في دينه بظواهر الألقاب ويرمي بعيدا باللباب. إذن يكون من الجاهلين، كيف والجمال هو الدين؟!
إن الصحوة الإسلامية المعاصرة لفي أشد الحاجة إلى تربية ذوقية فنية، ترهف حسها بمواطن الجمال، الموجِّهةِ لكل شيء في هذا الدين، عقيدةً وشريعة. ولقد انتبه السابقون إلى ذلك وانبهروا به فسارعوا إلى الالتحاق بقوافل المحبين. وكان منهم مُصَنِّفُون ذَوَّاقُون، نبهوا إلى هذه المعاني، من أمثال الحسن البصري والإمام المحاسبي والإمام الجنيد وابن الجوزي والإمام عبد القادر الجيلاني والإمام ابن القيم والإمام أبي عبد الله الساحلي المالقي والإمام الشاطبي والإمام أحمد زروق المغربي وغيرهم كثير، رحمهم الله أجمعين.
ألا ما أحوجنا اليوم إلى إعادة القراءة للدين، في مصادره العذبة الصافية الجميلة، قراءة تصل المسلم بالله، قبل أن تكون قراءة ينتقم بها لنفسه، من الظلم الاجتماعي، والطغيان السياسي، فيكون بتدينه عدوا للدين من حيث يدري أو لا يدري.
﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾(آل عمران: 8) ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاٌّ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءوفٌ رَّحِيمٌ﴾(الحشر: 10)
ذلك، وإنما الموفق من وفقه الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.