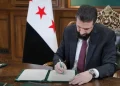من دروس الأستاذ فتح الله كولن:
سؤال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: “إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا”[1]؛ فما القاسمُ المشترك بين المسائل المذكورة في هذا الحديث؟ وما الذي تتضمَّنه من رسائل؟
الجواب: لقد احتفى القرآن الكريم بالكثير من قصص الأنبياء عبرةً وذكرى للمؤمنين، ومما كان مهمًّا في ذلك تبيانُ العاقبةِ الوخيمة للأممِ المكذِّبة، وتوضيحُ العقوبةِ الأليمة لمن يُصِرّ على الكفر والطغيان؛ فقومُ نوح عليه السلام أهلكهم الله بطوفانٍ عظيم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (سُورَةُ العَنْكَبوتِ: 14/29)، ويقول الله في عادٍ قومِ هودٍ عليه السلام: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾ (سُورَةُ الذَّارِيَاتِ: 41/51-42)، وفي قوم صالح عليه السلام: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾ (سُورَةُ القَمَرِ: 31/54)، وفي قوم لوطٍ قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ (سُورَةُ الْحِجْرِ: 74/15).
غير أننا لا ندري هل كانت الآفات الإلهية التي تعرضت لها الأمم السالفة مقتصرة على منطقةٍ معينة أم أنها عمّت سطح الأرض كلها! ولكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأنبياء السابقين كانوا يُبعَثون إلى أقوامهم خاصة فربما يمكننا أن نقول حينئذ بأن هلاك كل أمة كان محدّدًا بالمنطقة التي تعيش فيها، وعلى ذلك فإن الهلاك كان محصورًا في هؤلاء القوم الذين كفروا بأنبيائهم ولا يتعدى إلى غيرهم، ولكن لما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أُرسل إلى الناس كافة فإن هلاك أمته كان سيشمل كلَّ من كان على وجه البسيطة من الكافرين والظالمين الذين لم يستجيبوا لدعوته كما اقتضت سنة الله تعالى.
الدعاء المستجاب
ولهذا السبب دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك أمَّته بسَنة أي بطامّةٍ عامة؛ وإن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (سُورَةُ الأَنْفَالِ: 33/8)؛ لَيوضح لنا أن الله تعالى قد استجابَ دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.
وكما هو معلوم أن لرسولنا صلى الله عليه وسلم خصائص اختصّه الله تعالى بها، من هذه الخصائص المحمدية أن الأمة المحمدية لن تتعرَّضَ للهلاك العامّ الذي أصاب أقوام الرسل السابقين طالما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيهم، وهذه حقيقةٌ مسلّمٌ بها وفقًا للمعنى الظاهري للآية، غير أنه من الممكن استنباط المعنى التالي من الآية من حيث التفسير الإشاري: إن الله تعالى لن يعمّ الأمة المحمدية بعقابٍ عامٍ من عنده كما فعل مع الأقوام السابقين طالما عاش سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين الموحدين، فلو ترسخت الروح المحمدية بين المؤمنين فإن الله تعالى كما حفِظَ الأمة المحمدية في حياة مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم فَسيشملها بعد وفاته بعفوه ومغفرته ويكلؤها بحفظه ورعايته إلى يوم القيامة.
ولقد بينت الآية أيضًا أن الاستغفار هو أحد الوسائل التي تحفظ المؤمنين من الهلاك؛ فلو أن الأمة المحمدية إذا ارتكبت خطأً ما أو انحرفَت عن الطريق خطوةً استقامَتْ على الفور واستغفرَت ربَّـها؛ فإن الله تعالى سيحفظها من النوازل المحتمل وقوعها عن يمينها وشمالها ومن فوقها ومن تحتها، ولن يجعل عاليها سافلها.
خلاصة القول: إن الله تعالى قد استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بألا يعمّ أمته بهلاكٍ من عنده، ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة، وقرَّرَ التاريخُ هذا الأمر وأبانه بوضوح.
تكرُّرُ التاريخِ يشهدُ بأنَّ الأسرَ إن حَدَثَ فهو مؤقّت
ثم سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربَّه ألا يسلّط على أمته عدوًّا من غيرهم فاستجاب له؛ وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى بعين الغيب أن المؤمنين سيرزحون أحيانًا تحت نير الاحتلال، غير أن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، فبعد أربعة أو خمسة قرون من وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرَّض المسلمون للحملات الصليبية المتتالية، ومن بعدهم جاء المغول، واحتلُّوا بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، ولكن لم يدم بقاءُ هؤلاء جميعًا؛ إذ انهارَ الصليبيون والمغول ومَن جاؤوا بعدهم من الظالمين والمعتدين، وانتهى كلُّ هذا بفضلٍ من الله تعالى وعنايته.
والحقُّ أن الصليبيين قد أثخنوا العالم الإسلامي بالجراح؛ فقيّض الله تعالى “آلْب أَرْسْلان” و”مَلِكْشاه” و”قِلِيج أَرْسْلان” و”صلاح الدين الأيوبيّ” لِدحرهم وكفِّ أيديهم، فرجعوا من حيث جاؤوا وعادوا إلى بلدانهم بخفّي حنين، وبعد ذلك أعزَّ الله تعالى السلاجقة، وأتاح لهم فرصة القيام بمهمة حِفْظِ العالم الإسلامي لمدة قرنين من الزمان.
فلمّا ضعُف السلاجقة وشلّت حركتهم بسبب حركات التمرّد الباطنية بزغَ في وسط الأناضول كيانٌ جديد ملأَ كلَّ الآفاق وكأنه يرقةٌ خضعَتْ لِتحوُّلٍ جذريٍّ فأصبحَت فراشة.
أجل، قامت الدولة العثمانية بحفظ الحدود الشمالية للعالم الإسلامي، وكما يقول مالك بن نبي: “إن لم تكن الدولة العثمانية قائمة على ثغور العالم الإسلامي من ناحية الشمال لما كان هناك ما يسمى الآن بالعالم الإسلامي”؛ فقد حبا الله تعالى العثمانيين بإدارة الدولة والوصول بها إلى أعلى المستويات على مدى أربعة قرون من تاريخ الإنسانية، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده.
إن العالم الإسلامي في الوقت الراهن يرزحُ تحت أغلال احتلالات من نوعٍ آخر؛ فقديمًا كانت تُستخدم القوّة الغاشمة في فرضِ الاحتلال، أما الآن فقد أصبح الاحتلال يتحقَّق على يد دُمـًى من أبناء العالم الإسلامي، ومن خلالهم أحكم الآخرون السيطرةَ على هذا العالم؛ وما هذه الدُّمى إلا شخصيات لديها استعدادٌ فطريٌّ لخدمة أغراض الآخرين وأطماعهم، وبسببهم وقعَ العالم الإسلامي تحت الوصاية.
ولكن كما شهدنا تكرّرَ مثلِ هذه الحوادث على مدى التاريخ فإننا على أملٍ إن شاء الله بأن تنعم الأمة الإسلامية بحرِّيَّتِها واستقلاليتها، ومن يدري أيّ نملٍ سينخر في قصور الفراعنة مرة أخرى؟ وأيّ بعوضٍ سيدمّر النماردة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه هذا فاستجاب له، وبشَّرَه بأنه لن يُسلِّطَ على أمته عدوًّا من غيرها.
مصدر الخلاف: الضعف البشري
وأخيرًا نقول: إن مفخرة الإنسانية محمدًا صلى الله عليه وسلم قد رأى بعين الغيب ومن خلالِ أفقِهِ الواسع وفطنتِهِ العظمى أن الحرصَ والطمعَ والحسدَ والغيرةَ وحبَّ المنصب والشهرة والرغبة في الظهور وغير ذلك من المشاعر السلبية ما هي إلا نقاطُ ضعفٍ تُفرّق الناسَ وتشتتهم وتزرع الخلاف بينهم، وتجعل بَأسهم فيما بينهم؛ من أجل ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربَّهُ أن يحفظَ أمَّتَهُ من مثل هذا الخطر، ولكن لم يُستجب له.
لأنها مسألة ٌعلى الناس أن يتغلبوا عليها بإرادتهم، ورغم أن الحق تعالى لم يردّ دعاء نبيه كُلِّيَّةً ولم يقل له: “كلا، إنني سأذيق بعضَهم بأسَ بعض”؛ فقد أحالَ مسألة وحدتهم إلى إرادتهم؛ لأن الله تعالى -سامحوني- لم يخلق الإنسانَ بهيمةً، أو شجرةً أينما وُضعت لا تتحرك من مكانها، وإنما خلقه إنسانًا ومنحه الإرادة، ولذا على الإنسان أن يكافح ما تنطوي عليه نفسُه من مشاعر سلبية؛ مثل الحسد والغيرة والحقد والغِلّ، وأن يعطي إرادته حقها؛ حتى يتمكَّنَ من الرُّقيِّ في مدارجِ الكمالات الإنسانية إلى أعلى مراتبِها؛ وبعبارة أخرى: لم يعهد الله تعالى للأمة المحمدية بمسألة تحقيق الوفاق والاتفاق كمكافأة، وإنما ربط التوفيق في هذه المسألة في إطارِ الشرط العاديّ باستخدام الإنسان لإرادته.
من أجل ذلك لو أراد المؤمنون أن يتوافقوا ويتصالحوا ويتضامنوا فيما بينهم فعليهم أن يحتضنوا الجميع مثل الشيخِ الجيلاني وأبي الحسن الشاذلي ويونس أمره والأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي غفر الله لهم جميعًا، وأن يكونوا -فيما يخص حقوقهم الفردية- بلا يدٍ لِمَنْ ضربهم وبلا لسانٍ لمن سبّهم وبلا قلبٍ يغضب لمن كَسَرَ خاطرهم، وأن يُحافظوا على أن يكون بابُ الوفاق والاتفاق مفتوحًا على الدوام، فإن أَعطوا إرادتهم حقها ووُفِّقوا في هذا الأمر فلا بد أن تتحقَّقَ الوحدة والتضامن في هذه الدنيا بفضل من الله وعنايته، أما في الآخرة فسيحظون بألطافٍ إلهية من نوعٍ آخر، وسيعود عليهم جهدهم وسعيهم في هذه الدنيا بشكل مختلف تمامًا.
كالصاروخ على منصة الانطلاق…
وكما أن الإنسان يتحوّل إلى صرحٍ من العِفَّةِ عندما تلحّ عليه رغباته الشهوانية غير المشروعة فيقمعها ويوفِّي إرادته حقَّها، وكما يتحول إلى بطلٍ من أبطال الاستغناءِ إن اطَّلَعَ على ما أنعم الله به على الآخرين فلم يحسدهم أو يطمع فيما لديهم؛ فكذلك إذا ما أرغم الإنسانُ نفسَه على الوفاق والاتفاق وأعطى إرادته حقَّها يُصبحُ صرحًا من صروحِ الفضيلة.
أجل، قد يُسيء لكم البعضُ بإساءات لا يَتصورُ عقلٌ حدوثَها، ويضع الأشواك والأحجارَ في طريقكم حتى يمنعكم من السير، ويقوّض الجسور التي تمرون عليها ليعرقل مسيرتكم، ويرغب في أن يعزلكم كلّيةً عن المجتمع، ولكن إن كنتم تريدون أن تكونوا صروحًا للفضيلة وتصِلوا للوفاق والاتفاق فعليكم أن تتغاضوا عن كلِّ هذا وتستمرُّوا في طريقكم قائلين: “لا شيءَ يدوم!”، فإن انهدَمَت الجسورُ التي تسيرون عليها فأَقيموا جسورًا بديلة جديدة في أماكن أخرى، واستمروا في طريقكم بفضلٍ من الله وعنايته حذِرِينَ من الوقوعِ في الخلاف، حتى وإن كان الآخرون قد اتَّـخَذُوا الخلافَ شعارًا لهم.
سيأتي يومٌ يَـفِدُ عليكم فيه بعضُ مَن كانوا يسيؤون إليكم فيُعربون عن ندمهم، وحينئذ يجبُ أن يجدوكم على ما كنتم عليه، فإن طلبوا الاعتذار منكم فتعاملوا معهم بشهامة ومروءة، وقولوا لهم: “معاذ الله، لا علمَ لنا بهذا، إننا دائمًا نشعرُ أنكم إلى جانبنا في نفسِ الخندقِ على الدوام”.
نعم. اِفْعلوا هذا رغمَ أن الواقعَ يشهدُ بأنهم كانوا قد ابتعدوا عنكم فراسخ عددًا نتيجة الحسدِ والغيرةِ؛ وبأنَّهم دائمًا ما كانوا يؤلّبون الغير عليكم قائلين: “اقطعوا عليهم طريقهم، ونالوا منهم، ولا تعترفوا لهم بحق الحياة!”، وبأنهم حينما كانوا يرتكبون هذا الظلم لم تكن بحوزتهم حجج معقولة تقرّهم على ما يفعلون، بل كان دافعهم إلى هذا الحسد والغيرة ليس إلا، ولا شك أن شعور التنافسِ يكمن حتى داخل أكثرهم صفاءً وطُهرًا، فيحاول بعضهم احتكارَ بعض المجالات لنفسِهِ ولا يسمح للآخرين بالمشاركة فيها.
وهكذا فإنها لَميزةٌ عظيمة بالنسبة لأرباب الحقِّ أن يتغاضوا عن كل هذا، ولا يعتدّوا به وكأنه ما كان، وأن يثبتوا على موقفهم.
قراءةُ طبيعة البشر قراءة صحيحة
من جانب آخر ينبغي ألا ننسى أنه من المتعذر الحفاظ دائمًا على الوفاق والاتفاق، فالخلاف في بعض المسائل قائمٌ بين الناس على الدوام؛ لأن الإنسان فُطِرَ على ذلك؛ ومن ثمّ فعلينا أن نعترفَ بحقيقةِ أنه من الممكن أن نرى تصرُّفاتٍ لا نتوقَّعُها في ظلِّ الظروف الراهنة، وإن كنا نسعى لتحقيق الوفاق والاتفاق بين الناس فعلينا أن نعترف بذلك حتى لا يتسرَّب اليأسُ إلى نفوسنا بسبب خيبة الأمل التي قد تصيبنا عند مواجهة الأحداث المريرة التي تُحرق الفؤاد.
وقد جعل اللهُ مثلَ هذا الوفاق والاتفاق بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يحيطون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومِنَ الذين جاؤوا مِن بعدهم مَنْ وُفِّق -على مستوى الظِّلِّيَّة لأن ما يخص أصحاب رسول الله أصلٌ- لتوطيد علاقات الأخوة مع من حوله ولِإقامة بنيانٍ مرصوصٍ معهم من أجل الحفاظ على روح الوحدة والتضامن مقتفيًا آثار الصحابة الكرام وعلى مقدمتهم سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعًا، كما شهدنا هذا بين طلائعِ الرعيلِ الأوّل من طلبة الأستاذ النورسي رحمه الله، ولكن لا يمكن القول إن مثل هذا الصفاء والنقاء قد تمَّ الاحتفاظُ به دائمًا بسبب ما خالطه من مفاهيم مختلفة وآراء فلسفية متباينة.
أجل، قد توجد بعض نقاط الضعف لدى كل إنسان، وقد يقوم البعض بتصرفات تخلّ بالتناغم العام للهيئة التي ينتمون إليها، وقد لا يقدر البعض الآخر على أن يستوعبوا شعور الوحدة والاتحاد، ولا يستطيعون إذابة جليد أنانيتهم في حوض الشخصية المعنوية للمسلمين فيخسرون ذلك الحوض الكبير، فعلينا إزاء كل هذا أن نقيّم الأمور بِسَعَةِ ضمير، وألا نغضب لِأخطاء البعض وقصورِهم، فلا نُبعدهم عنّا، بل نحاول كسبَهم، ونسعى في إصلاحهم، حتى نوصّل المهمة التي حمَّلَنا الله إياها إلى برِّ الأمان قدرَ استطاعَتِنا.
لقد أمر القرآن الكريم في كثيرٍ من آياته المؤمنين بأن يدفعوا السيئة بالحسنة، وأن يتمثّلوا العفو والسماح، وعلى ذلك يجب علينا أن نتعامل وفقًا للضوابط التي حددها لنا القرآن الكريم، وأن نتغاضى عن العيوب قدر الإمكان، وإلا أرهبْنا الكثيرين وجعلناهم يلوذون بالفرار من أمامنا، وهذا أيضًا يضر بالجماليات التي نُحاول القيام بها في سبيل مرضاة الله تعالى.
أجل، إن كنا نريد الحفاظ على الوفاق والاتفاق فعلينا ألا ننبذ أحدًا أو نعزله أو نُقْصِيه بسبب أخطائه وعيوبه، بل لا بدَّ أن نبحثَ عن السبل التي توصلنا إلى قلوب الجميع، وعلينا أن نجدَها، ثم نحاول احتضانهم وإصلاحهم.
[1] سنن الترمذي، الفتن، 14؛ سنن ابن ماجه، الفتن، 9.
من موقع herkul.org