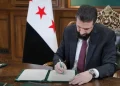بقلم: يافوز أجار
كان أبو سعيد وعد أبناءه سليمان وسعيد وفتح الله أن يذهب بهم إلى المتحف الأثري في وسط المدينة. وهذان الأخيران يدرسان معاً بجامعة الشرق الأوسط في كلية اللغة العربية وآدابها.
بدأ سليمان الصغير ينتظر الموعد بفارغ الصبر. ولما أتى يوم الخميس؛ يوم الموعد، استيقظ من نومه قبل أفراد أسرته، حتى أمّه؛ وراح ينادي والديه وأخويه حتى يستيقظوا. ولما نهضت أمّه، واعتدلت في الفراش، وأسندت ظهرها إلى الوسادة، فإذا بابنها أمام باب الغرفة! لم يكن من الصعب تمييزه من الأضواء المنعكسة إلى وجهه من مصباح الصالة، فاستغربت ذلك كثيراً، وفكّرت في نفسها “كيف استيقظ سليمان بهذا الوقت المبكر من الفجر؟ ولماذا؟” فقالت له ماسحة عينيها بيديها؛ حيث يتقطّر منهما النوم:
– خيراً يا سليمان، ماذا بك؟ ماذا تريد في هذه الساعة؟
– قومي يا أمّي! ألا تعرفي أن اليوم يوم الخميس؟ ألا نذهب اليوم جميعاً إلى المتحف الأثري؟
لما عرفت أمه سبب قيام ابنها في وسط الليل ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة. وبعد ثوانٍ قام أبو سعيد، ومن بعده كل من فتح الله وسعيد أيضاً. فذهبوا جميعاً إلى المسجد وصلّوا الفجر. ثم عادوا إلى البيت وتناولوا الفطور. والآن كلّهم مستعدّون للذهاب إلى المتحف الأثري. وكان قلب سليمان ينبض بحرارة.
شاهدوا في المتحف كثيراً من المخطوطات والكتب القديمة، والملابس الشعبية، وأنواعاً كثيرة من الأحجار الكريمة. وقد وقع بصر سليمان على حجرين جميلين ملتمعين، فأُعجِب بهما إعجاباً شديداً، فأخذهما كَتِذكار؛ إذ أراد بهما أن يتذكَّر تلك الزيارة. هذان الحجران كانا من أحسن الآثار المعروضة في المتحف. ولم يمض كثير من الوقت حتى اكتشف الموظّفون أنَّ الأحجار ناقصة. وبعد قليل من البحث والتفتيش، عثروا عليهما بيد سليمان الصغير، فانتزعوهما من يده بصعوبة. واستغرب سليمان معاملة هؤلاء الموظَّفين له هكذا من أجل هذين الحجرين الصغيرين. وحاول أبوه إقناعه بأنهما ليسا من الأحجار العادية، بل هما حجران تاريخيّان خاصّان قيِّمان جداًّ تبقّيا من العصور القديمة، فاقتنع بما قال أبوه، واعتذر منه ومن الموظّفين هناك عن صنيعه هذا.
وبعدما أنهوْا هذه الزيارة الممتعة، اقترح أبو سعيد لأبنائه أن يقوموا بزيارة أخرى في المدينة، حيث قال:
– ما رأيكم، هل نذهب إلى المسجد الكبير التاريخي؟ نزوره ونصلّي فيه، وفي الوقت نفسه نستريح في حديقته الكبيرة.
اتفقوا على ذلك وذهبوا معاً إلى المسجد. وبعد الصلاة جلسوا في الحديقة للاستراحة، فأكلوا من الفواكه وشربوا من العصائر.
لفت انتباه سليمان شيءٌ غريب جداً وهم يأكلون ويشربون؛ إذ شاهد صخرة عظيمة لم يشاهد مثلها في حياته من قبل، فذهب منه عقله. ليست الصخرة هي التي استوقفته وذهب منها عقله، وإنما الأزهار الصفراء والورود الحمراء والأعشاب الخضراء التي نبتت عليها، فسأل أباه قائلاً:
– يا أبت! كيف تستطيع زهرة صغيرة ضعيفة رقيقة كالشعرة أن تخترق تلك الصخرة العظيمة القوية الصلدة، وتخرج رأسها من خلالها؟ كيف تنبت فيها تلك الأزهار والورود والأعشاب؟ إن هذا لشيء عجاب!
أراد أبو سعيد أن يثير فضول سليمان، فردّ عليه قائلاً:
– إن سرّ ذلك يكمن في “بسم الله”!
فوجئ سليمان بهذا الردّ المحيّر، فلذلك استفسر أباه. وهذا هو ما أراده أبوه.
– وكيف ذلك أبي؟!
– كما أنك إذا أردت أن تباشر عملاً ما تقول “بسم الله”، فتبادر وتقوم به، كذلك تلك الأزهار والأعشاب تقول “بسم الله”، فتشقّ الصخور الصلدة بشعيراتها الحريرية الرقيقة وتنمو حتى تستوي على سيقانها. تنتشر بذور الأعشاب والأزهار في أماكن مختلفة من خلال الرياح والحشرات المختلفة، وعندما يأتي موعد الانبعاث من تحت الأرض تقول “بسم الله”، فتنطلق وتنبت بسهولة، وإن اعترضت أمامها عقبات كتلك الصخور الصلدة وما شابهها؛ وذلك لأنها تتحرّك “بسم الله”.
وهنا تدخّل سعيد ليقول:
– يا أبتِ، أنا أرى أن نبات الأزهار والأعشاب في التراب ليس أقلّ إعجازاً من الذي ينبت خلال الصخور الصلدة، فكلاهما معجزة تعجز العقول عن إدراكها. ولكن ستار الإلفة والعادة يريه لنا كأمر بسيط عادي.
– بارك الله فيك يا بنيّ! فضول سليمان انفتح بنا إلى عالم واسع وموضوع مهم جداً: إن هذه الدنيا “دار الحكمة والامتحان”؛ فَيَدُ القدرة الإلهية تعمل هنا من وراء ستار الأسباب المادية والقوانين الكونية التي وضعها الله لتدور عليها عجلة الكون؛ وسرّ الامتحان يقتضي ألا تكون يد القدرة العاملة فيه واضحة وضوح الشمس، بل يقتضي أن تكون هناك أبوابٌ ونوافذُ لينفذ منها أولو الألباب إلى الحقيقة الناصعة بإعمال فكرهم واستعمال عقولهم. فلو كانت واضحة وضوح الشمس لما بقي للعقل والإرادة أيّ دور، وكذلك أيّة قيمة، ولما تبيّنت مستويات الناس من الإيمان والكفر أبداً. ومن أجل ذلك، وبمقتضى الحكمة الربانية، وبموجب كثير من الأسماء الحسنى كالحكيم، والمرتّب، والمدبّر، والمربّي، يخلق الله سبحانه وتعالى الأشياء في هذه الدنيا بشيء من التدريج ومع الزمن. أما الآخرة فـ”دار القدرة والرحمة”، فلا حاجة إلى الأسباب الماديّة والمدّة والزمن، حيث ينشئ الأشياءَ هناك نشأة آنية. وما يشير إليه القرآن الكريم بـ﴿… وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ…﴾ (النحل:77)، هو أن ما ينشئ الله هنا من الأشياء في يوم واحد وفي سنة واحدة، ينشئ هناك في لمحة واحدة كلمح البصر. وكما أن الله تعالى يُظهر بالنظام والتناسق المتمثّلين في السنن الكونية قدرته وحكمته وعدم تدخّل أي مصادفة لعجلة هذا الكون، كذلك يُظهر سبحانه وتعالى بشواذّ القوانين الكونية، كما في معجزات الأنبياء عليهم السلام، وبخوارق عاداته، كتلك الأعشاب والأزهار النابتة خلال الصخور الصلدة، مشيئته وإرادته، ويلفت الأنظار إلى أنه الفاعل المختار؛ وأن اختياره لا يرضخ ولا يخضع لأي قيد كان، ممزّقاً بهذا ستار الرتابة والاطراد. وبذلك يظهر للإنسان أن كل شيء، في كل آن، في كل شأن من شؤونه، بحاجة إليه سبحانه وتعالى، ومنقاد لربوبيته، فيشتّت الغفلة، ويصرف أنظار الجنّ والإنس عن الأسباب إلى خالق الأسباب.
وهنا طرح فتح الله سؤالاً في منتهى الأهمية على أبيه:
– يا أبت! لماذا يضع الله الأسباب المادية أمام إجراءاته وتصرفاته، ويدير عجلة الكون من خلال القوانين الفيزيائية التي هي السنن الإلهية، فلا تشاهَد يد قدرته فيها مباشرة؟
فردّ أبوه بقوله:
– لأن معظم الناس غافلون جاهلون لا يدركون المحاسن الكامنة في الحوادث، ولا يعرفون حِكمها، فيشتكون بلا حقّ، ويعترضون جهلاً، فوُضعت الأسباب لتتوجّه الاعتراضات والشكاوى إليها. وإذا أفلحوا في درك تلك المحاسن والحكم تنقشع سحب الأسباب المادية عن أنظارهم، فتتجلى يد القدرة في كلّ شيء وحادثة.
– وقد قيل بتمثيل معنوي: إنّ عزرائيل عليه السلام اشتكى إلى الله تعالى بأن عبادك يشتكون منّي في قبض الأرواح؛ لأنهم لا يدركون أوجه الحسن والرحمة الكامنة في وجه الموت العبوس، فأوحى الله إليه أنّي أضع بينك وبينهم وسائط المصائب من الزلازل والسيول والأمراض…الخ، حتى تتوجّه شكاواهم إليها، لا إليكَ.. في الحقيقة أن عزرائيل عليه السلام هو بالتالي وسيط؛ لأن الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس. وخلاصة القول: إن عزة الله وعظمته تقتضيان وضع أسباب ظاهرية لردّ شكاوى الناس الباطلة، ولئلا يرى العقل الظاهريّ مباشرةَ يد القدرة بالأمور الخسيسة الجزئية. ولكن التوحيد والجلال يردّان أيدي الأسباب المادية الجامدة عن التأثير الحقيقي.
وهنا أبرز سعيد مهارته اللغوية وتمكُّنه من أساليب القرآن، حيث قال:
– إذن علينا أن نكشف غطاء الأسباب الماديّة والقوانين الطبيعية عن الكون حتى تكون لنا أبصار حديدة، وبصائر نافذة، لنتمكّن من رؤية يد القدرة العاملة الحقيقية فيه.
سيطر أبو سعيد على الموقف مجدداً بعد تلك الملاحظة اللطيفة لابنه.
– وبذلك تبيّن لنا أن كلّ شيء في هذا الكون، سواء كان صغيراً أو كبيراً، يتحرّك ويتوقّف بأمر الله تعالى وإذنه؛ فالكون بجميع عناصره عباد مسلمون، وجنود منقادون مطيعون لأوامره، لكن لا يتمتّعون بإرادة، وليس لهم حرية العصيان، على النقيض من الإنسان؛ فإنه يتمتّع بالإرادة، وله حريّة العصيان، إلا أنه يلقى جزاءه في الدنيا أو العقبى غالباً. فالأشياء من الذرات إلى المجرّات تقوم بوظائفها حسب الخاصيات والميّزات التي ركّب الله تعالى فيها، وإلا ليس للأشياء خاصيات وميّزات “ذاتية” لا تنفصل عنها. فسبحان الذي قال: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ، ، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ: اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً. قَالَتَا: أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا…﴾ (فصلت:11-12).
وحينما انتهى أبو سعيد من قراءة الآية قال سعيد:
– يا أبت! تذكّرت آية عظيمة في سورة (هود)، تقصّ علينا قصّة الطوفان بعبارات وجيزة بليغة جداً: ﴿وَقِيلَ: يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. وَغِيضَ المَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ. وَقِيلَ: بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (هود: 44).
أحسنت يا من سعد حظّه!
– كأن قائداً عظيماً في حرب عالمية شاملة يأمر جيشه بعد تحقيق النصر: “توقّفوا عن إطلاق النار”. ويأمر جيشه الآخر: “توقفوا عن الهجوم”. ففي اللحظة نفسها ينقطع إطلاق النار، ويتوقف الهجوم، ويتوجّه إليهم قائلاً: “لقد انتهى كل شئ، وانتصرنا على الأعداء، وقد نُصبت راياتنا على بروج قلاعهم، ونال أولئك الظالمون الفاسدون جزاءهم، وولّوْا مدبرين إلى أسفل سافلين”. كذلك مالك الملك سبحانه وتعالى، الذي لا ندّ له ولا مثيل، قد أمر السمواتِ والأرضَ كجنديين مطيعين مستعدّين لطاعته وتلقّي أوامره بإهلاك قوم نوح. وبعد أن امتثلا الأمر توجّه إليهما قائلاً: “أيتها الأرض ابلعي ماءَك، وأنتِ أيتها السماء اسكني واهدئي، فقد انتهت مهمّتكما”. فانسحب الماء فوراً من دون تريّث، واستوت سفينة المأمور الإلهي كخيمة ضربت على قمة جبل، ولقي الظالمون جزاءهم.
وهنا أراد أبو سعيد أن يشرك ابنه الصغير سليمان في الحوار حتى لا يكون غريباً وثقيلاً عليه ما يتحدّثون، فلذلك قال متوجّهاً إليه:
– فمثلاً يا سليمان! ألِلْبحر أو الماء خاصية الإغراق؟
– بالطبع يا أبت! ألا تتذكّر أنّ ابن جارنا ياسر قد غرق في المسبح وتوفي؟
وكان أبوه ينتظر منه هذا الجواب أو مثله.
– إذن فكيف تعيش الأسماك في البحر دون أن تغرق وتموت يا بنيّ؟!
وفوجئ سليمان بهذا السؤل؛ لأنه لم يفكّر هكذا قطّ.Ç
واستمرّ أبوه قائلاً:
– إن الأسماك لا تستطيع العيش في البرّ بسبب خاصياتها وخاصيات البرّ التي ركّبها الله فيهما؛ كما أن الإنسان لا يستطيع العيش في البحر بسبب خاصياته وخاصيات البحر التي ركّبها الله فيهما. إلا أن مفعول وتأثير تلك الخاصيات بيده سبحانه وتعالى؛ فإذا أراد أن يبطله أبطله، وليس لتلك الخاصيات إلا الانقياد والإذعان لأوامره. فتأثير خاصيات وميزات الأشياء منوط بإرادة الله تعالى وإذنه. ولذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم بصدد بيان حاكميته المطلقة:
﴿… مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا…﴾ (هود: 56).
﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ…﴾ (الزمر: 62-63).
﴿فَسُبحَانَ الَّذي بيدهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شئٍ﴾ (يس: 83).
﴿وإنْ من شئٍ إلاّ عِندَنا خَزائِنهُ…﴾ (الحجر: 21).
وما إن قرأ أبو سعيد تلك الآيات حتى انفرجت عينا سليمان على سعتهما، يبدو أنه تذكّر شيئاً، فقال:
– ليس للنار خاصّيّة الإحراق أيضاً!! وكذلك ليس للبحر خاصّيّة الإغراق!! فإن النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام! وكذلك البحر لم يُغرق موسى عليه السلام. فقد أنجاه الله ومن معه من المؤمنين من الغرق في البحر، بينما أغرق آل فرعون فيه. فهذان الأمران يدلاّن على أن النار والبحر يتحرّكان بأمر الله وإذنه.
فرح أبوه بنجاحه في إشراك ابنه الصغير في هذه المحاورة وقال:
– أحسنت يا سليمان! بارك الله فيك!
– كما قلتَ يا سليمان، فإن الله سبحانه وتعالى قال للنار: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (الأنبياء: 69)، فأبطل خاصية الإحراق التي ركّبها هو فيها. وهي (النار) بدورها كعبدٍ مسلم مطيع لخالقها لم تحرق العبد الحنيف الحليم الأواه المنيب؛ أبو الأنبياء عليه وعليهم السلام. وكذلك الأمر في انفلاق البحر كمعجزة للنبيّ موسى عليه السلام، كما قصّ علينا القرآن الكريم: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (الشعراء: 63).
وحاول فتح الله الإسهام في الحوار من خلال توجيه سؤال لأبيه :
– يا أبت، حسب ما فهمت مما تفضّلت، أن الكون عبد مسلم. وبما أن السنن الكونية الإلهية هي التي تدير عجلة الكون، ننتهي من ذلك إلى أن الدين الذي يدين به الكون بما فيه من كل شيء هو الإسلام. والفارق بين الكون والإنسان هو أن هذا الأخير يتمتّع بالإرادة والحرية، أليس كذلك أبي؟
– بلى فتح الله! أحسنت! ذلك الأمر بيّنه القرآن الحكيم بياناً لا يدع مجالاً لأيّ شك:
﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ…﴾ (آل عمران: 19).
﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (آل عمران: 83).
– ولأن الكون لا يطغى على النظام الذي وضعه الله له فلا يحدث فيه أيّ فوضى وأيّ اختلال في سير عجلته، بل يسود فيه الانتظام الكامل، والانسجام الشامل. أما الإنسان فإن الله تعالى جعله حرّاً طليقاً، وأعطاه إرادة جزئية ليبتليه بها على شكره وصبره، أو على كفره وشكواه، حتى يميز الطيّب من الخبيث، والمسلم المطيع الطائع من الكافر العاصي الكاره، ثم يجازيه على كلّ ما عمِل من خير أو شرّ، بالجنة أو النار. ولأن الإرادة الجزئية للإنسان تتدخّل في أمورهم الشخصية والاجتماعية ضمن دائرة الإرادة الكلية لله تعالى، فالأمور تضطرب وتختلّ، والروابط الشخصية والأسرية والاجتماعية التي أمر الله بها أن توصل تنقطع وتنحلّ. ولكن الإنسان إذا ما جعل إرادته الجزئية تابعة للإرادة الكلية الإلهية، أي دان بالدين الذي يدين به جميع ما في الكون، يسود في حياتهم الشخصية والاجتماعية النظام والانتظام والانسجام، كما يسود في جنبات قلوبهم السعادة والاطمئنان، مثلما يسود في الكون، إن لم تطله يد الإنسان.
– والمسلم في الحقيقة هو من نجح في تحقيق السلام والوئام مع نفسه وربِّه والكونِ المحيط به والناسِ (بني جنسه) من حوله على اختلاف معتقداتهم وأعراقهم وأجناسهم. ويمكن استخراج ذلك من هذه الآية عن طريق إعمال مبدإ “المفهوم المخالف”: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (البقرة: 27).
كان فتح الله يستمع لحديث والده بأذن واعية وأراد أن يلفت الانتباه إلى موضوع آخر:
– إذن ليس هناك داعٍ للخوف من بعض الظواهر الكونية كالرعد والبرق والزلزلة وما شاكلها؛ لأن كلها “عباد مسلمون يتحرّكون بسم الله وبإذن الله وبأمر الله”. يا أبت! أنا انتهيت إلى نتيجة عظيمة مما تحدّثتم قد يجهلها كثير من الناس، وهو: أن الإنسان المسلم منسجم ومتناغم مع الكون، فليس هناك صراع بين “العبدين المسلمين”، كما يصوّره بعض الفلسفات الغربية الزائفة.
ولكن التعليق الذي وضع نقطة لهذا الحوار الإيماني صدر من سليمان الصغير، حيث قال:
– يا أبت! بما أن كلّ شيء يقول “بسم الله“، فيتبع أوامره سبحانه وتعالى في جميع حركاته وسكناته، فأنا أيضاً سأعطّر فمي دائماً بـ”بسم الله” في صغير أعمالي وكبيرها!